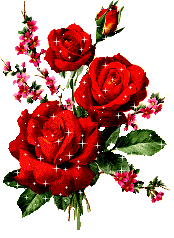✿قہہمہہر✿
بزونة المنتدى
- إنضم
- 22 أبريل 2016
- المشاركات
- 129,693
- مستوى التفاعل
- 2,640
- النقاط
- 114
تنمية المجتمع من المنظور الإسلامى
إن تنمية مجتمعاتنا وإصلاحها ودعمها والدفاع عنها هو مطلب شرعي أولاً ، وهو استثمار طويل الأجل ثانياً حيث يتوفر المناخ الآمن الصالح للعيش الكريم وتفتح الشخصية ونموها .
ولكي يتضح لنا مفهوم تنمية المجتمع علينا أن نعرض لبعض المفاهيم ذات الصلة الوثيقة بالمجتمع والتنمية ، والتي منها:
1 ـ إن المجتمع في جوهره تعبير إنساني عن مجمل العقائد والمفاهيم والأعراف والعلاقات والمصالح التي تسود رقعة مكانية معينة ، وتخضع لها مجموعة بشرية محددة .
2 ـ إن للعقيدة دوراً مهماً في تحديد ماهية الفعل الاجتماعي ؛ إذ إنها تحدد اتجاهه، كما أنها تفسره ، وتظهر مسوغاته ، وتكشف عن منطقيته ، كما أنها تحدد أهدافه ، وترشد إلى كثير من نظمه ووسائله([1]).
3 ـ إن كثيراً من النظريات التي حاولت الكشف عن السلوك الاجتماعي تمت في الغرب ، وعلى أسس وأصول ، وفي إطار مفاهيم وافتراضات غربية ، ولذا فإن تلك الدراسات والكشوفات قد تفيد المجتمعات الغربية لأنها خرجت من رحم ثقافتها ، لكنها تبدو قاصرة إذا طبقت على مجتمعاتنا الإسلامية .
إن فهم واقعنا على نحو جيد يتطلب معايشة ممتازة له من خلال دراسات وتقنيات خاصة وكثيفة ، وفي إطار مفاهيم ومعطيات إسلامية ومحلية ، ولابد إلى جانب ذلك أن نكون قادرين على التحرر من كثير من العادات والتقاليد والتراكمات التي شكلت رؤيتنا للحياة بعيداً عن المنهج الرباني .
4 ـ للفكر دور مهم في بناء المجتمعات ، وفي تغييرها ؛ إذ إنه يوفر لنا الأدوات التي تمكننا من استيعاب الواقع الاجتماعي ، حيث يستحيل التعامل مع أي واقع اجتماعي إلا من خلال تكوين صورة ذهنية عنه ، والفكر هو الذي يشكل هذه الصورة .
غير أن الأفكار تبقى محدودة القيمة على الصعيد الاجتماعي العملي ما لم تحدث تغييراً في مؤسسات المجتمع ونظمه ، وعلى سبيل المثال ، فإنه إذا ساد المجتمع نوع من الخوف من المستقبل وعدم الاطمئنان إليه ، فإن الحل لا يكمن في دعوة الناس إلى الاطمئنان ، وإنما في إنشاء أوضاع اجتماعية يشعر معها الناس بالأمن عن طريق تقوية الإيمان بالله ، ورحمته بخلقه ، وعن طريق تدعيم العلاقات الاجتماعية والقرابية ، وإنشاء بيوت لرعاية كبار السن ، وتكفل الدولة بضمان الحد الأدنى من العيش الكريم لكل مواطن.
5 ـ إن من المهام الأساسية للتنمية الاجتماعية دعم العلاقات الاجتماعية ، علاقات الأخوة والقرابة والجوار والزمالة والضيافة ، وتنمية مفاهيم التقدير والتسامح والفهم المتبادل ، وهذا ما تفعله كل التعاليم والآداب الإسلامية التي تهدف إلى تقريب الناس بعضهم من بعض ، ومن ثم فإن هذه المسألة يمكن أن تكون معياراً مهماً لمدى التقدم الذي يحدثه أي مجتمع مسلم([2]).
إن المجتمع العام يتألف سياسياً واجتماعياً من الأسرة ، والمجتمع المدني ، والدولة (الحكومة) ، وكل له دوره المنوط به في التنمية الاجتماعية ، وسنعرض هنا بشيء من الإيجاز لدور كل واحد منها في هذه التنمية.
1 ـ الأسرة ودورها في التنمية:
يمثل البيت المسلم إحدى الدعائم الأساسية في بناء الشخصية الإسلامية إذ هو المحضن الأول للطفل والمقر الدائم لحياة الفرد، وما دامت المدرسة في تعليمها إنما تنطلق من عقيدة الأمة وأهدافها وثقافتها وتاريخها وكل جوانب المعرفة وروافد العلم التي تتضافر على تكوين الشخصية المسلمة، فإن دور البيت ينبغي أن يكون دوراً أساسياً لمساعدة وتدعيم كل المعارف والحقائق التي يتلقاها الفرد في المدرسة فتسير معها في اتجاه واحد يحقق التعاون والانسجام، وإذا كانت المدرسة تمثل الجانب النظري في الإعداد، فإن البيت ينبغي أن يكون محلاً للتطبيق العملي لما يتلقاه الفرد في المدرسة، ويزيد في تبصيره بكثير مما تعجز المدرسة عن تغطيته، فإذا تحقق هذا التلاحم بين البيت والمدرسة كان لذلك أثره البعيد في تكوين الفرد وصلاحه واستقامة سلوكه، أما إذا حصل أي تناقض أو اختلاف بين ما يأخذه الطالب في المدرسة، وما يمارسه في البيت أو يشاهده في المنزل، فإن ذلك يورث اهتزازاً في القيم، وتذبذباً في النفس، وازدواجية في التفكير، وبالتالي يحدث خللا في بناء الشخصية وتكوينها وتقل تطلعاتها.
والأسرة عندما يدرك أفرادها ما يجب عليهم فهمه من نصوص شرعهم، ودلالات دينهم، ويحرصون على ذلك عملاً، فإن نتيجة ذلك الالتزام بالأخلاق، ومراقبة الأعمال لتزنها من منطلق الفهم الصحيح، حتى توجه الأبناء منذ حداثة أعمارهم التوجيه السليم، وتغرس في نفوسهم حب الفضيلة لفضلها، وعمق أثرها، وكراهية الرذيلة لسوئها، وآثار نتائجها؛ لأن الرذيلة يتمثل فيها شبح الجريمة التي يحسن بالأسرة تجسيمها لدى الناشئة، وإيصاد الطرق المؤدية إليها؛ ليكبر هذا الإحساس معهم، فيرونها شبحاً مخيفاً، وعملاً رذيلاً، تكبر أحاسيسهم حياله مع الأيام، حتى إذا كبروا، وصاروا في موطن المسئولية، وعمق الفهم، أدركوا بالدليل الشرعي سر ما رسخ في قلوبهم، ودور ما أنشئوا عليه من أعمال وأفكار، حيث أدرك ذلك المفهوم التربوي الشاعر العربي في قوله:
وينشأ ناشئ الفتيان منا ... على ما كان عوده أبوه
وأسوة المسلمين في ذلك منهج الصحابة، وفهم التابعين في حسن توجيههم لأبنائهم، وتلقينهم الفضيلة طبعاً وخلقاً وتعويدهم الأعمال الحميدة ترويضاً ومتابعة، حيث تابعوا التطبيق مع أقرب الناس إليهم، ونشئوا محبين لكل عمل مستحسن، آلفين كل منهج سليم، سائرين على الفطرة السليمة، التي هي تعاليم الإسلام الصحيحة؛ لأن كل مولود يولد على الفطرة، والإسلام وتشريعاته هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فالأسرة المسلمة في كل عصر ومصر عندما يهتم أربابها بأبنائهم تربية وحسن خلق، وإنكارا للمنكر، وتحذيرا من الصغائر، التي حذر منها رسول الله r بقوله: «إياكم ومحقرات الذنوب » أي ما تحتقره النفس ويصغر في العين، فإن هذا من أسباب توفر البيئة الصالحة ؛ لأن صلاح الأحداث، وتعظيمهم شرائع الله، والوقوف عند حدوده، دافعه الزاجر الإيماني، والتربية السليمة التي حرصت الأسرة على تمكينه في جوانب البيت، ضمن التربية الأولية التي يلقنها الآباء والأمهات لأبنائهم، فالكبير يمتثل ويوجه ويضرب النموذج الصالح بالقدوة والالتزام، أما الصغار فيبين لهم أن ذلك العمل ما هو إلا استجابة لشرع الله الذي جاء به الإسلام تربية وتوجيهاً وتعليماً وتطبيقاً.
فالصغير عندما يتعود ذلك عملاً، وتنطبع به أخلاقه سلوكاً، فإن الأمر سيعظم في قلبه، والمصدر الذي جاء منه وهو كتاب الله، وسنة رسوله r ، الذي استجاب من أجلها، سيكون له مكانة راسخة في أعماقه؛ لأن هذا من تعظيم حرمات الله، كما قال تعالى: ) ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ (([3])، وقوله سبحانه: ) وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (([4]).
إن الأسرة التي تحرص على غرس الروح الإيمانية في قلوب أبنائها، منذ تفتح براعمهم، فإنما تحصنهم لمجابهة الحياة، والاستعداد لإدراك المخاطر؛ لأنالإيمان بالله وبكتبه وبملائكته وبرسله، وباليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، ترسيخ هذا الإيمان يعطي الأبناء سلاحاً قوياً يدفعهم للعمل، وينمي عندهم بغض الشر، وإدراك خطره، ويحبب إليهم الخير، ويرغبهم في البحث عن مداخله، والاستئناس بأهله؛ لأن من شب على شيء شاب عليه، وبذلك يسلم الأحداث- بتوفيق من الله- من الجنوح في صغرهم، ومن ثم الابتعاد عن الجريمة في كبرهم؛ لأنها لم تجد في قلوبهم باباً مفتوحاً، ولا ارتياحاً يدفعها للاستقرار.
ومعلوم أن من يركب مخاطر اليم، إذا لم يكن قادراً على السباحة، فإنه يعرض حياته للموت، ونفسه للخطر، بل أبسط ما يقال عنه: إنه قد ألقى بنفسه إلى التهلكة؛ لأنه لم يستعد من قبل بما يعينه على مصارعة الأخطار، والقدرة على توقي أضرارها([5]).
*****
2 ـ المجتمع المدني ودوره في التنمية:
المقصود بالمجتمع المدني : " النقابات ، واتحادات العمال، والمؤسسات والهيئات والجمعيات الخيرية، والنوادي ، ومجموعة المنظمات غير الحكومية ، والغرف التجارية ، والاتحادات المهنية التي يربط بين أعضائها رباط اجتماعي ليس قائماً على القرابة أو الدين... ويكون الترابط والتضامن فيها قائماً على الوعي وتبادل الاحتياجات والمواقف في الأزمات مثل العجز أو المرض أو الوفاة أو حالات الاعتداء([6]) .
وللمجتمع المدني جانب سياسي لأنه هو البنية التحتية للحياة السياسية وهو سبب نشوئها واستمرارها الشرعي ، بمعنى أن " المجتمع المدني هو الأصل والأساس العقلي لأية شرعية سياسية وهو المسئول عن سلامة أو فساد الحياة السياسية ، فإذا كانت الديمقراطية مزيفة ، والناس سلبيين غير عابئين بما يحدث ، وغير مشاركين في الحياة السياسية فإن هذا يرجع غالباً إلى عدم سلامة وفعالية البنية التحتية للحياة السياسية أعني المجتمع المدني"([7]).
إن المجتمع المدني هو ـ أو هكذا ينبغي أن يكون ـ المساحة الحرة والمنظمة بين الأسرة والدولة ، وهو مجتمع مفتوح حر ومنظم بشكل ذاتي ، وليس بشكل خارجي أو قهري ، أي ليس منظماً من قبل الدولة ، بل منظماً تنظيماً داخلياً بواسطة أعضائه والقوانين التي وضعوها بالأسلوب الديمقراطي ، وارتضاها المجتمع العام ، ويربط بين الناس بروابط ثقافية أو اجتماعية أو مهنية أو سياسية أو اقتصادية ، أو أية رابطة مدنية أخرى تقوم على العمل التطوعي، والإرادة الحرة وتبادل المصالح المستنيرة المشتركة([8]).
أركان المجتمع المدني :
يقوم المجتمع المدني على ثلاثة أركان :
(1) ـ الإرادة الحرة : فالمجتمع المدني يقوم على الانتماء التطوعي الحر بملء الرغبة وكامل القناعة الذاتية بناء على وعي اجتماعي وسياسي .
(2) ـ التنظيم : فكل جمعية أو هيئة أو رابطة في المجتمع المدني لها نظام ولوائح تحدد شروط العضوية ومنهج العمل داخلها كما يوجد نظام عام يحكم ويحدد العلاقات بين أجزاء المجتمع المدني ، ويحكم العلاقة بينه وبين الدولة .
(3) ـ التسامح وقبول التعددية: فالتعددية سنة كونية لا سبيل للقضاء عليها سواء على مستوى المجتمع الواحد أو على مستوى المجتمع العالمي ، وفيه يوجد قبول كامل لهذه التعددية واعتراف بها وتسامح تجاه ما ينتج عنها من اختلافات ، كما أن لديه التزام أخلاقي بالإدارة السلمية للاختلافات عندما يحدث صراع([9]).
المبادئ التي يقوم عليها المجتمع المدني:
يقوم المجتمع المدني على مجموعة من المبادئ أهمها ما يلي:
1 ـ المساواة المستنيرة . 2 ـ حماية الجماعات الضعيفة والأقليات.
3 ـ الحرية والاستقلال الفردي . 4 ـ التناول الديمقراطي للسلطة .
5 ـ مشاركة الحكومة في التنمية . 6 ـ الشفافية والرقابة المتبادلة .
أنماط من تنظيمات المجتمع المدني في الحضارة الإسلامية :
عرف المجتمع المدني في الحضارة الإسلامية أشكالاً متعددة مما نطلق عليه الآن اسم مؤسسات المجتمع المدني مثل الأوقاف وطوائف الحرف والتجار والأخويات .
ويشكل نظام الأوقاف لبنة أساسية للتكافل الاجتماعي بعيداً عن دور الدولة ، وكانت الأوقاف تلعب دوراً كبيراً في بنيان الأمة أو المجتمع المدني حيث كانت تساهم في التوازن الاجتماعي والاقتصادي فهي خدمة عامة تقدم للناس ابتغاء وجه الله تعالى، وكانت الأوقاف متنوعة فهي تشمل كافة الخدمات من إصلاح الطرق العامة وإنشاء الجسور وعمارة المساجد وتقديم الخدمات الطبية وكفالة الأيتام واللقطاء والفقراء ومساعدة طلبة العلم ومساندة المزارعين فيأخذون بذور أرضهم مجاناً ، ومساعدة صغار التجار بعطايا أو بقروض حسنة بلا فوائد وتزويج الفقراء من الشباب ذكوراً وإناثاً ، وكفالة العميان والمقعدين ، بل وتقديم الألبان للأمهات الفقيرات ، وتقديم العون لابن السبيل.
ولنأخذ إحدى عواصم الحضارة الإسلامية كنموذج للدور العظيم الذي كانت تقوم به الأوقاف في حياة الناس ، يقول ابن بطوطة : " والأوقاف بدمشق لا تحصر أنواعها ومصارفها لكثرتها فمنها أوقاف على العاجزين عن الحج تعطى لمن يحج عن الرجل منهم كفايته ، ومنها أوقاف على تجهيز البنات إلى أزواجهن ، وهن اللواتي لا قدرة لأهلهن على تجهيزهن ، ومنها أوقاف لفكاك الأسارى ، ومنها أوقاف لأبناء السبيل يعطون منها ما يأكلون ويلبسون ويتزودون لبلادهم ، ومنها أوقاف على تعديل الطرق ورصفها ؛ لأن أزقة دمشق لكل واحد منها رصيفان في جنبيه يمر عليهما المترجلون ، ويمر الركبان بين ذلك ، ومنها أوقاف لسوى ذلك من أفعال الخير([10]).
أما الأخويات فهي في الأساس نظام صوفي وجد خارج نطاق المسجد فيما كان يسمى الزاوية أو الرباط أو التكية ، وكان أعضاؤها يشكلون نظاماً اجتماعياً يطلق عليه النظام الأخوي ، ومع أن الانضمام لهذا الشكل من التنظيم كان مفتوحاً لكن كان لابد من توافر بعض الشروط منها التأكد من وجود إرادة حرة ورغبة حقيقية وقناعة ذاتية.
وتطورت الأخويات فأصبحت تضم لها أفراد حرفة معينة ، أو معظمهم ، ومن ثم أصبحت تشكل قاعدة اتحاد عمال أو نقابة مصغرة ، وهو ما يمكن أن نطلق عليه : الشراكة على أساس الاهتمامات والمصالح المشتركة.
أما التنظيمات المهنية التي كانت تضم أهل كل حرفة في تنظيم واحد له مصالحه المشتركة وطرقه الذاتية في التكافل بين أعضائه فهي مسألة معروفة تماماً وهي إن لم تكن تشتمل على اللوائح والآليات الموجودة الآن لكنها ـ بلا شك ـ كانت تمثل قاعدة نقابة.
ومن أشكال المجتمع المدني كذلك ما كان يعرف ولا يزال نجده حتى الآن في مصر وفي عدد من الدول العربية نظام المضايف والمجالس العرفية ، ومجالس العرب لفض المنازعات بعيداً عن الدولة أو القضاء .
إن هذه كلها أشكال المجتمع المدني في مجتمعاتنا ينبغي الحفاظ عليها أو استعادتها ، ثم تطويرها وتحديثها عن طريق التوعية بالآليات والممارسات المعاصرة وتوسيع نطاق دورها ثم تكوين أشكال جديدة لكي تعمل بجوار هذه التكوينات التقليدية([11]).
الدور المنوط بالمجتمع المدني:
1 ـ على المجتمع المدني تبادل الرقابة والنقد والنصيحة بينه وبين الحكومة في إطار الدستور والقانون .
2 ـ على المجتمع المدني مراقبة الأمن في المجتمع المحلي الصغير بدون اعتداء على الحريات الشخصية والإبلاغ عن الحوادث التي تقع من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما أن عليه أن يقوم بنوع من الرقابة الذاتية على نفسه ضد الفساد الداخلي.
3 ـ على المجتمع المدني أن يحمي الأفراد من القوة الطاغية لبعض الجهات ذات القوة في الدول المختلفة وللنقابات ومنظمات حقوق الإنسان دور كبير في هذا الصدد .
4 ـ للمجتمع المدني دور كبير في مساعدة الحكومة في المساهمة في تقديم الخدمات العامة ، ورعاية الأيتام والمعاقين والمسنين وتقديم الخدمات العلاجية ومحو الأمية .
5 ـ على المجتمع المدني عبء كبير في مجال البيئة : أعمال النظافة في المجتمع المحلي والإبلاغ عن المصانع والورش الملوثة للبيئة ، وزراعة المناطق المحيطة بالبيوت وأمامها واستغلال المساحات الفارغة لعمل حدائق ..إلخ.
6 ـ على المجتمع المدني مساعدة الحكومة في مكافحة البطالة من خلال تقديم القروض الحسنة ، أي القروض بلا فوائد ، لتشجيع المشروعات الاقتصادية الصغيرة وعمل دورات تدريبية لنقل وتنمية المهارات الإنتاجية التي تساعد على تهيئة العاطلين للعمل ، أو تساعد الذين يرغبون في تطوير أنفسهم وتحسين مستوى عملهم أو تغيير مجاله .
7 ـ على المجتمع المدني عمل برامج فعالة وعملية لنشر الوعي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في مختلف الطبقات ولاسيما الطبقات الدنيا والتركيز على نشر ثقافة التنمية والإنتاج وتفعيل مشاركة المواطنين وتهيئة المناخ العام لجعل كل مواطن يشعر بأن أي عمل إيجابي ـ مهما كان صغيراً ـ سوف يساهم في عملية التنمية والتقدم ، وغرس مفاهيم عمل الخير الإيجابي الذي ينعكس على عملية التنمية والبناء والتعمير والإنتاج([12]).
*****
3 ـ الدولة أو الحكومة ودورها في التنمية:
مسؤولية الدولة: إذا كان الإسلام قد أعطى عناية كبيرة لوسائل التكافل الفردية فإنه لم يكتف بها بل أقام إلى جانبها الوسائل العامة التي جعلها من مسؤولية الدولة ومن واجباتها الاجتماعية.
ومن أهم هذه الوسائل:
أ- تأمين موارد المال العام:
وذلك باستثمار المحيط الطبيعي للدولة وما ينطوي عليه من ثروات باستخراج معادن الأرض وكنوز البحار وكافة الثروات التي أودعها الله في الكون واستخلف فيها الإنسان وجعله سلطانا على تسخيرها والانتفاع بها في حياته ليتحقق أقصى حد للرفاهية الاجتماعية الشاملة التي لا تقتصر على فئة دون فئة أو مجال دون آخر.
ولو أن كل دولة قامت بواجبها في هذا المجال ووزعت نتائج هذه المصادر بالقسط - خدمات عامة وفرص عمل- لأقبلت المجتمعات الإنسانية كلها على نهضة جبارة.
ب- إيجاد فرص عمل للقادرين عليه:
وذلك بالبحث عن أفضل الحلول لمواجهة البطالة وبإقامة المشاريع البناءة التي تساهم في النهضة العامة, وتوفر في ذات الوقت فرص العمل للأيدي العاطلة بعدالة تامة ومراعاة للحاجات العامة وإعطاء الأولوية للفئات الفقيرة المحرومة, ونذكر هنا تلك الحادثة التي لها دلالتها حيث جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله فأعطاه درهما وأمره أن يشتري به فأسا ويذهب إلى (تحذير رابط هكر لاتضغط عليه) فيحتطب ويأتيه بعد فترة فلما جاءه أخبره أنه وفر قدرا من المال لحاجته وتصدق بالبعض الآخر فقال r : «لأن يأخذ أحدكم حبله ويحتطب خيرا له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه»([13]).
ج- تنظيم وسائل التكافل الفردي:
فالدولة مسئولة عن تنظيم الوسائل الفردية للتكافل - سابقة الذكر- وخاصة الزكاة والوقف, وذلك بإقامة السياسات اللازمة لتحقيق أهداف تلك الوسائل المتمثلة في القضاء على الفقر وتقريب الهوة الاجتماعية بين الموسرين والمحرومين , وإيجاد الضمانات اللازمة لتحقيق ذلك.
فعندما يتعرض المجتمع لأوضاع غير عادية يصل فيها التفاوت الاجتماعي إلى حد غير مأمون وتعجز الدولة بمواردها العامة عن تلبية الحاجات الاجتماعية وعن القيام بوظائفها وواجباتها تجاه المجتمع, فلا مانع بل يجب - في رأي معظم فقهاء الإسلام - أن تفرض الدولة في أموال الأغنياء ما يحقق ذلك حتى تعود الأوضاع إلى حالتها السوية على أن تكون في ذلك قوامة بالقسط وأن تكون الدوافع الحقيقية هي خدمة الصالح العام.
الضمان الاجتماعي في الإسلام:
ويراد به التزام الدولة الإسلامية نحو كافة المقيمين بها، أيا كانت ديانتهم أو جنسياتهم، وذلك بتقديم المساعدة للمحتاجين منهم في الحالات الموجبة بتقديمها كمرض أو عجز أو شيخوخة، متى لم يكن لهم دخل أو مورد يوفر لهم حد الكفاية، ودون أن يطلب تحصيل اشتراكات مقدمًا.
والأخذ بالضمان الاجتماعي في الإسلام، هو من قبيل تطبيق النص أي ما ورد بالقرآن والسنة فيما يتعلق بالزكاة وهذا ما يميز الضمان الاجتماعي في الإسلام، عن التأمين الاجتماعي والذي يمكن الأخذ في الإسلام بموجب المصلحة، والتأمين الاجتماعي كما هو معروف تتولاه الدولة والمؤسسات الخاصة، ويتطلب مساهمة المستفيد باشتراكات يؤديها، وتمنح له مزايا التأمين أيا كان نوعها وذلك متى توافرت له شروط استحقاقها بغض النظر عن فقره أو غناه([14]).
******
4 ـ ـالأوقاف الخيرية ودورها في التنمية :
الوقف الخيري أحد أبرز سمات المجتمع المسلم، ارتبط بالوجود الإسلامي في المدينة، ومارسه المسلمون تلبية لأوامر الإسلام العقدية والتعبدية والخلقية ولحاجات الناس، حيث شمل الوقف كل جوانب الحياة وأوجه الإنفاق على دور العبادة والتعليم والخير.
أهمية الوقف وأدلة مشروعيته:
الوقف جائز ومشروع بنصوص عامة من القرآن الكريم وأخرى مفصلة من السنة.
أما الكتاب فقوله تعالى: ) وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ(([15])، وقوله تعالى: ) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (([16]) أي من الصدقات والوقف منها فهو مندوب إليه، وقوله تعالى: ) وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (([17]) ، وقوله تعالى: ) وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ (([18])، وقوله تعالى: ) وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ (([19]).
ومن السنة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله r قال: " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"([20])، والصدقة الجارية محمولة على الوقف عند العلماء، فإن غيره من الصدقات ليست جارية، بل يملك المتصدق عليه أعيانها ومنافعها.
وحديث وقف عمر بن الخطاب، فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما «أن عمر أصاب أرضا من أرض خيبر، فقال يا رسول الله: أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالاً أنفس منه، فما تأمرني، فقال: " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" قال: فتصدق بها عمر على ألا تباع ولا توهب ولا تورث، في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول"([21]).
قال الحافظ ابن حجر: "وحديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف"([22]).
وعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أن النبي r قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال: " من يشتري بئر رومة فيجعل منها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي"([23]).
وعن عائشة - رضي الله عنها- «أن رسول الله r جعل سبع حيطان له بالمدينة صدقة على بني المطلب وبني هاشم"([24])، وبعد ذلك تتابع الصحابة رضوان الله عليهم في الوقف.
فنظام الوقف إذن باعتباره نظاماً خيرياً موجود منذ القدم بصور شتى، إلا أنه من المؤكد أن نظام الوقف في الإسلام بشكله الحالييبقى خصوصية إسلامية لا يمكن مقارنتها بصور البر في الحضارات أو الشعوب الأخرى وهذا عائد إلى عدة أمور:
1 - التعلق الشعبي به وامتداد رواقه ومظلته إلى أمور تشف عن حس إنساني رفيع.
2 - عدم اقتصار الوقف على أماكن العبادة كما هو في الأديان السابقة، بل امتد في نفعه إلى عموم أوجه الخير في المجتمع.
3 - شمول منافع الوقف حتى على غير المسلمين من أهل الذمة، فيجوز أن يقف المسلم على الذمي لما روي أن صفية بنت حيي - رضي الله عنها - وقفت على أخ لها يهودي.
ويتميز الوقف بخصائص وميزات متعددة قد لا توجد في المشاريع الخيرية الأخرى، وهذه المزايا أكسبته تلك الحيوية التي استمر أثرها في الأمة على مدى قرون طويلة؛ لأجل ذلك لا عجب أن نرى ذلك الإقبال الكبير من لدن أفراد المجتمع المسلم على الوقف وتحبيس جزء كبير من أملاكهم لأعمال الخير، وقدوتهم في ذلك نبيهم محمد r ثم صحبه الكرام، فقد وقف مجموعة من أصحاب النبي r منهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير بن العوام ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة وصفية زوجات الرسول r وأسماء بنت أبي بكر وسعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد وجابر بن عبد الله وغيرهم، رضي الله عنهم أجمعين، ومن بعدهم من التابعين وتابع التابعين.
ثم سار من بعدهم الأغنياء والموسرون من المسلمين فأوقفوا الأوقاف وأشادوا الصروح، بنوا المساجد، وأنشئوا المدارس وأقاموا الأربطة، وهؤلاء الأخيار والأغنياء الأبرار لم يدفعهم إلى التبرع بأنفس ما يجدون وأحب ما يملكون، ولم يتنازلوا عن هذه الأموال الضخمة والثروات الهائلة إلا لعظم ما يرجون من ربهم ويأملون من عظيم ثواب مولاهم، ثم الشعور بالمسئولية تجاه الجماعة والأقربين، دفعهم ذلك كله إلى أن يرصدوا الجزيل من أموالهم ليستفيد إخوانهم أفرادا وجماعات، جمعيات وهيئات، أقرباء وغرباء.
وفي عهد العباسيين كان لإدارة الوقف رئيس يسمى (صدر الوقف) أنيط به الإشراف على إدارتها وتعيين الأعوان لمساعدته على النظر عليها.
ولما تولى العثمانيون مقاليد السلطة في معظم البلاد الإسلامية اتسع نطاق الوقف لإقبال السلاطين وولاة الأمور في الدولة العثمانية على الوقف، وصارت له تشكيلات إدارية تعنى بالإشراف عليه وصدرت تعليمات متعددة لتنظيم شئونه وبيان أنواعه وكيفية إدارته، ولا زال الكثير من هذه الأنظمة معمولا بها إلى يومنا هذا.
الحكمة من مشروعيته:
قال بعض أهل العلم: الوقف شرع لمصالح لا توجد في سائر الصدقات، فإن الإنسان ربما صرف مالا كثيرا ثم يفنى هذا المال، ثم يحتاج الفقراء مرة أخرى أو يأتي فقراء آخرون فيبقون محرومين، فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شيء وقفا للفقراء وابن السبيل يصرف عليهم من منافعه ويبقى أصله([25]).
لقد أمر الإسلام بكل ما يقوي عرى الصلة والتراحم بين المسلمين عامة ويحقق التكافل فيما بينهم، وحض على التعاون والتكاتف في كل سبل الخير والبر والمعروف، قال تعالى: ) وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (([26]) ، والوقف فيه تحقيق لكلا الغرضين، التكافل العام بين المسلمين، والتكافل الخاص في نطاق الأسرة الواحدة.
ولما كان المال محببا إلى النفوس ويصعب على المرء التفريط فيه، فقد شرع الإسلام حبس عين المال، والتصدق بمنفعتها وفي هذا تحقيق لرغبة الإنسان المتمشية مع ما جبل عليه من حرص على المال، وذلك لأن عين ماله باقية في الوقف ليس لأحد التصرف فيها.
كما أن في الوقف تحقيقا لمصالح الأمة وتوفيرا لاحتياجاتهم ودعما لتطويرها ورقيها، وذلك بما يوفره من دعم لمشروعاتها الإنمائية، وأبحاثها العلمية، وذلك أن الوقف لا يقتصر على الفقراء وحدهم وإنما يمتد نفعه ليشمل كثيرا من المجالات التي تخدم البشرية.
وإذا كان المسلم حريصا على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويرجو الثواب في الدنيا والآخرة، فإن الله سبحانه فتح أمامه أبواب الخير العديدة ومنها الوقف، إضافة إلى أن الوقف في الإسلام من أهم المؤسسات التي كان لها دور فعال في الحضارة الإسلامية لكافة جوانبها الدينية والاقتصادية والاجتماعية وحراسة الدين، ومن أهم آليات حراسة الدين بناء المساجد وعمارتها لإقامة الصلوات التي تعد عماد الدين، وكان الوقف وما يزال المصدر الرئيس لتوفير التمويل اللازم لذلك، هذا إلى جانب أن وقف الكتب وإقامة المكتبات وإقامة حلقات التعليم في المساجد تعمل في مجال حراسة الدين كما تعمل في مجال التنمية البشرية.
ويلعب الوقف دوراً هاماً في مكافحة الفقر وإنشاء المدارس والمستشفيات والطرق والجسور، ومصادر المياه الصالحة للشرب، وغيرها من مؤسسات التنمية الاجتماعية والحضارية، وظهر للوقف قديما دور في النشاط الزراعي بوقف الأراضي الزراعية واستغلالها لحساب مستحقي الوقف.
ومما يبرز أهمية الوقف أن بعض الدول غير الإسلامية والمتقدمة منها مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ينتشر الوقف بها رغم أنه ليس وراء ذلك دافع ديني إسلامي، ورغم كثرة المبتكرات لديهم من أساليب تمويل الخدمات الاجتماعية إلا أنهم أخذوا صيغة الوقف كما جاء بها الإسلام وطبقوها في مجالات عديدة مثل المستشفيات والجامعات، ومواجهة الكوارث وتقديم الإعانات للفقراء، كل ذلك يؤكد لنا أن مؤسسة الوقف ليست عملا تراثيا من الماضي ولم يعد له حاجة في الوقت الحاضر، بل على العكس دوره مطلوب بشدة الآن، وله ما يبرره ويجب العمل على إحيائه بكل السبل.
تقوم فكرة الوقف نفسها على تنمية قطاع ثالث متميز عن كل من القطاع الخاص، والقطاع الحكومي، وتحميل هذا القطاع مسؤولية النهوض بمجموعة من الأنشطة هي - بطبيعتها - تدخل في إطار البر والإحسان والرحمة والتعاون، لا في قصد الربح الفردي، ولا ممارسة قوة النظام وسطوته؛ لأن هذا النوع من الأنشطة قائم على المودة والمرحمة.
فالوقف إخراج لجزء من الثروة الإنتاجية في المجتمع من دائرة المنفعة الشخصية ودائرة القرار الحكومي معا، وتخصيص لذلك الجزء لأنشطة الخدمة الاجتماعية العامة، وقد قررت الشريعة الإسلامية أن هذه الأنشطة والخدمات هي حاجة بشرية، لا تقتصر على المجتمع الإسلامي فقط بل هي لغير المسلمين أيضا.
ويعد الوقف بمفهومه الواسع أصدق تعبيرا وأوضح صورة للصدقة التطوعية الدائمة، بل له من الخصائص والمواصفات ما يميزه عن غيره، وذلك لعدم محدوديته واتساع آفاق مجالاته، والقدرة على تطوير أساليب التعامل معه، وكل هذا كفل للمجتمع المسلم التراحم والتواد بين أفراده على مر العصور بمختلف مستوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها الأمة الإسلامية خلال الأربعة عشر قرنا الماضية، فنظام الوقف مصدر مهم لحيوية المجتمع وفاعليته، وتجسيد حي لقيم التكافل الاجتماعي التي تنتقل من جيل إلى آخر حاملة مضموناتها العميقة في إطار عملي يجسده وعي الفرد بمسؤولياته الاجتماعية، ويزيد إحساسه بقضايا إخوانه المسلمين، ويجعله في حركة تفاعلية مستمرة مع همومهم الجزئية والكلية.
إن الدارس للوقف في الحضارة الإسلامية ليعجب من التنوع الكبير في مصارف الأوقاف، فكان هناك تلمس حقيقي لمواطن الحاجة في المجتمع، لتسد هذه الحاجة عن طريق الوقف، فالوقف من حيث بعده الاجتماعي يبرهن على الحس التراحمي الذي يمتلكهالمسلم ويترجمه بشكل عملي في تفاعله مع هموم مجتمعه الكبير، ويظهر هذا جليا في رصد التطور النوعي للوقف على امتداد القرون الأربعة عشر، فقد كان المسجد أهم الأوقاف التي عني بها المسلمون، بل هو أول وقف في الإسلام، كما هو معلوم في قصة بناء مسجد قباء أول مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، ولعل من أبرز شواهد اهتمام المسلمين بذلك الجانب في الوقف: الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والجامع الأزهر بالقاهرة، والمسجد الأموي بدمشق والقرويين بالمغرب، والزيتونة بتونس وغيرها كثير، ثم يأتي في المرتبة الثانية من حيث الكثرة العددية والأهمية النوعية المدارس، فقد بلغت الآلاف على امتداد العالم الإسلامي، وكان لها أثر واضح في نشر العلم بين المسلمين، وقد أدى توافد طلاب العلم من جميع أنحاء العالم إلى مراكز الحضارة الإسلامية والعواصم الإسلامية إلى إنشاء الحانات الوقفية التي تؤويهم، مع تهيئة الطرق، وإقامة السقايات والأسبلة في هذه الطرق للمسافرين، وكذا دوابهم.
وصاحب ذلك إنشاء الأربطة ودور العلم للطلاب الغرباء لإيوائهم، واستتبع ذلك ظهور الوقف للصرف على هؤلاء الطلاب باعتبارهم من طلاب العلم المستحقين للمساعدة في دار الغربة، ولا تخلو كل هذه المراحل والأنواع من جوانب اجتماعية للوقف، إلا دلالتها وأهميتها وأثرها في المجتمع بشكل عام.
كما أن للوقف دورا فاعلا في مجال الرعاية الاجتماعية، يتمثل ذلك في المدارس والمحاضن التي أنشئت خصيصا للأيتام، يوفر لهم فيها المأكل والأدوات المدرسية، كما يتمثل دور الوقف في مجال الرعاية الاجتماعية في الأربطة بالإضافة إلى الأسبلة التي يقصد بها توفير ماء الشرب للمسافرين وعابري السبيل وجموع الناس، سواء داخل المدن أو خارجها، وقد أدت دورها الاجتماعي باقتدار رغم صعوبة استمرار مثل هذه المؤسسات الاجتماعية وبقائها فترات طويلة وعلى مدى أجيال متوالية، ويعود ذلك إلى حاجتها الكبيرة إلى موارد مالية دائمة لا تتوقف ولا تنضب، وقد تحقق لها ذلك بفضل من الله ثم بفضل نظام الوقف الذي ازدهر في تصاعد مع ازدهار الحضارة الإسلامية، ذلك أن الملاحظ في كثير من حلقات التاريخ وفي العديد من بلاد العالم توقف مؤسسات خيرية ضخمة عن أداء رسالتها بعد فترة من الزمن، بسبب نضوب مواردها المالية وإفلاسها، مما اضطرها إلى طلب مساعدة الخيرين بين حين وآخر، أما في الحضارة الإسلامية فإنه قل أن تجد مثيلا لهذه الظاهرة.
الأهداف الخاصة للوقف:
للوقف عند المسلمين عدة أهداف خيرية واجتماعية حميدة، منها ما يقصد به المجتمع ومنها ما يقصد به حماية الأسر وتلاحمها وترابطها وتعاونها على البر والتقوى بصفتها اللبنة الأولى للمجتمع ومنها ما يعود على الموقف نفسه من أجر وثواب يناله بسبب الوقف وإليك أهم أهداف الوقف:
1 - تحقيق مبدأ التكافل بين الأمة المسلمة وإيجاد التوازن في المجتمع فإن الله - سبحانه وتعالى- جعل الناس مختلفين في الصفات متباينين في الطاقة والقدرة، والوقف عامل من عوامل تنظيم الحياة بمنهج حميد يرفع من مكانة الفقير ويقوي الضعيف، ويعين العاجز، ويحفظ حياة المعدم، من غير مضرة بالغني ولا ظلم يلحق بالقوي، وإنما يحفظ لكل حقه بغاية الحكمة والعدل، فتحصل بذلك المودة وتسود الأخوة ويعم الاستقرار، وتتيسر سبل التعاون والتعايش بنفوس راضية مطمئنة.
2 - في الوقف ضمان لبقاء المال ودوام الانتفاع به والاستفادة منه مدة طويلة، فإن الموقوف محبوس أبدا على ما قصد له لا يجوز لأحد أن يتصرف به تصرفا يفقده صفة الديمومة والبقاء.
3 - في الوقف استمرار للنفع العائد من المال المحبس، فثوابه مستمر لموقفه حيا أو ميتا وداخل في الصدقة الجارية التي أخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنها من العمل الذي لا ينقطع، وهو أيضا مستمر النفع للموقوف عليه ومتجدد الانتفاع منه أزمنة متطاولة([27]).
4 - للوقف هدف أعلى وأسمى من بقية الأهداف وهو امتثال أمر الله - سبحانه وتعالى- بالإنفاق والتصدق والبذل في وجوه البر، كما في الآيات التي سبق ذكرها وغيرها من الآيات المماثلة، كما أن فيه امتثالا لأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة وحثه عليها.
5 - في الوقف تحقيق لأهداف اجتماعية واسعة وأغراض خيرية شاملة كدور العلم والوقف على طلبة العلوم الشرعية والعلوم المباحة التي تعود بالنفع على المسلمين والتي هي من متطلبات المجتمع المسلم، وما يتبع ذلك من أبحاث ودراسات تكون من وسائل تنمية المجتمع المسلم وإغنائه عما بيد عدوه.
وقد قام على الوقف جامعات علمية نشرت نورها على الأرض، وحملت رسالة الإسلام إلى الناس، وبسبب الوقف وحده نشطت في البلاد الإسلامية حركة علمية منقطعة النظير غير متأثرة بالأحداث السياسية والاجتماعية التي سادت بلاد المسلمين، فوفرت للمسلمين نتاجاً علمياً ضخماً وتراثاً إسلامياً خالداً، وفحولاً من العلماء لمعوا في التاريخ العالمي كله([28]).
فمن الوقف يمكن إيجاد مؤسسات وقفية تعمل بحرية كاملة بعيدا عن المؤثرات الخارجية تؤدي غرضا أو أغراضا متعددة تخدم المجتمع، وتساهم فينشر الإسلام وتبلغ رسالته تدعم تلك المؤسسات الوقفية من قبل من يسر الله لهم أموالا تزيد عن حاجتهم.
كما أن في تلك المؤسسات تحقيقا لغرض كثير من الأفراد الذين يرغبون في فعل الخير ولكن أعمالهم والتزاماتهم تمنعهم من ذلك أو ليس لديهم الخبرة الكافية للقيام بتلك الأعمال فإذا وجد من يخدمهم باستغلال ما ينفقونه على سبل الخير من المتخصصين في مجال الاستفادة به بما يحقق الغاية منه دفعهم هذا إلى كثرة الإنفاق لاطمئنانهم إلى أن عائد ما ينفقونه سوف يصرف في مصرفه السليم.
6 - بالوقف يمكن للمرء أن يؤمن مستقبله ومستقبل ذريته بإيجاد مورد ثابت يضمنه ويكون واقيا لهم عن الحاجة والعوز والفقر، فقد جبلت النفس البشرية على الحرص على المال وفي الوقف وسيلة مباحة لتحقيق تلك الرغبة.
7 - في الوقف وسيلة لحصول الأجر والثواب من الله تعالى وتكثيرها. كما أن فيه وسيلة للتكفير عن الذنوب ومحوها، وفي الكل تحقيق للراحة والطمأنينة النفسية في الدنيا، والفوز بنتائج ذلك في الدار الآخرة.
8 - في الوقف حماية للمال ومحافظة عليه من عبث العابثين كإسراف ولد أو تصرف قريب، فيبقى المال وتستمر الاستفادة من ريعه، ويدوم جريان أجره له.
9 - وأيضا في الوقف بر للموقوف عليه وقد حث الشرع الكريم على البر ورغب فيه ففي البر تدوم الصلة وتنقطع البغضاء ويتحاب الناس فتسمو الهمم وتأتلف القلوب وتتعاون على الأمور النافعة وتتجنب الكيد للآخرين وتتجه إلى العمل المنتج النافع. كما أن ذلك من أسباب ترابط الأسرة الواحدة وتماسكها وهي اللبنة الأولى للمجتمع.
10 - في الوقف تطويل لمدة الانتفاع من المال ومد نفعه إلى أجيال متتابعة، فقد تتهيأ السبل لجيل من الأجيال لجمع ثروات طائلة ولكنها قد لا تتهيأ للأجيال التي تليه فعن طريق الوقف يمكن إفادة تلك الأجيال اللاحقة بما لا يضر الأجيال السابقة.
11 - الحاجة ماسة إلى الوقف ففيه تحقيق لكثير من الأهداف والأغراض التي ذكرنا، وبعدمه يحرم المجتمع منها([29]).
الطرق والأساليب الداعمة للوقف:
هناك جملة من الطرق والأساليب الداعمة للوقف وإرجاعه إلى دوره الرائد في دعم الأعمال الخيرية والعلمية والاجتماعية وغيرها، للوصول إلى ما يطمح إليه الجميع بإذن الله فمن ذلك:
1 - تنفيذ حملة إرشاد وتوعية تهدف إلى إبراز قيمة الصدقات وأجر الإنفاق في سبيل الله، وبخاصة ما كان منها صدقة جارية (الوقف) للإقبال على إحياء هذا النظام وجعله يؤدي دوره.
2 - استمرار عقد الندوات العلمية المتخصصة في الأوقاف وطرحها بشكل موسع بحيث تكون المشاركات من دول العالم الإسلامي وعدم قصرها على المستوى المحلي.
3 - إبراز دور الوقف الاجتماعي في النهضة الإسلامية وطرحها عبر القنوات الإعلامية، مع التركيز على ضرورة التنوع في مصارف غلال الأوقاف وفق حاجات المجتمع كي تسد ثغراته الاجتماعية.
4 - طباعة أبحاث الندوات التي أقيمت عن الوقف في كتب وطرحها في الأسواق للبيع وعدم الاقتصار على التوزيع المجاني لها.
5 - تحويل جميع عمليات الوقف من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي منظم من خلال إنشاء صناديق وقفية متخصصة يندرج ضمنها الأوقاف القائمة حاليا، وما يستجد من أوقاف في إطار واحد تحدده شروط الواقفين.
وتخصص هذه الصناديق المقترحة للقيام بالأنشطة الشرعية والثقافية والصحية بالإضافة إلى الأنشطة الاجتماعية من خلال إنفاق ريع أموال الواقفين بما يحقق أغراضهم، وتتكون موارد كل صندوق من ريع الأموال والأعيان الوقفية ويقوم على إدارة كل صندوق لجنة متخصصة، وتساعد مثل هذه الصناديق على توفير رأس مال كبير من مجموع الأوقاف المتناثرة، مما يعطي فرصة أكثر لتنمية رؤوس الأموال وإنشاء مشاريع تحقق تنمية واسعة.
ويمكن لتلك الصناديق دعم المشاريع الخيرية التي تتوافق مع شروط الواقفين، بحيث تقوم أية جهة بتقديم مشروع متكامل من حيث الدراسة والتنفيذ ونوعية ومقدار المستفيدين منه، ليقوم الصندوق بدراسة المشروع وتحديد مدى إمكانية دعمه وفق معايير واضحة، بذلك نضمن تحقيق أكثر فائدة من الأوقاف في المجالات المختلفة.
6 - استصدار نظام للأوقاف يتضمن تعريفه، وتنظيمه، وحمايته، بنوعيه الخيري العام والذري (أو الأهلي) الخاص.
7 - حماية أموال الأوقاف الموجودة من عقارات ومبان وأموال منقولة، والمحافظة عليها من الغصب والضياع والتعطيل، وحفظ سجلاتها.
8 - العمل على استرداد أملاك الأوقاف التي حولت إلى استعمالات أخرى بطرق غير مشروعة، ومراجعة السجلات القديمة للأوقاف في المحاكم والدوائر العقارية وغيرها لتحديد الأملاك الوقفية والبدء بإجراءات إعادتها إلى ميدانها الوقفي.
9 - إعادة النظر في إدارة أملاك الأوقاف، وبخاصة الأوقاف الاستثمارية، بما ينسجم مع إرادة الواقفين وشروطهم من جهة، ومع نصوص الشريعة ومقاصدها من جهة أخرى.
10 - وضع النظم اللازمة للتعريف بالأوقاف الخيرية العامة والأهلية الخاصة، وبيان دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتشجيع قيام أوقاف جديدة، وإعادة إدخال الأوقاف الذرية في البلدان التي ألغتها، وبخاصة بعد أن اتجهت عدة مجتمعات معاصرة متطورة إلى تأكيد أهمية هذا النوع من الأوقاف وتشجيعها.
11 - تقديم المعونات المادية والفنية والتمويلية والإدارية للأوقاف، بنوعيها الخيري والأهلي.
12 - وضع الخطط اللازمة لاستثمار الأملاك الموجودة للأوقاف وتنميتها، التي تعطلت عن العطاء خلال العصور المتأخرة لأسباب تاريخية كثيرة، وتوفير فرص التمويل المناسبة لها.
13 - تكليف وزارة الأوقاف في كل بلد بالعمل على تشجيع إنشاء أوقاف جديدة، وإقامة الهيكل المؤسسي اللازم للمساعدة في إنشاء أوقاف جديدة، وتشجيع الأفراد على إقامتها وتقديم التسهيلات الضريبية والإدارية وغيرها، وكذلك الإعانات الإدارية والمالية لها حتى تتمكن من أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي([30]).
*****
5 ـ التكافل الاجتماعي ودوره في تنمية المجتمع:
التكافل الاجتماعي:
يقصد بالتكافل الاجتماعي: أن يكون أفراد المجتمع مشاركين في المحافظة على المصالح العامة والخاصة ودفع المفاسد والأضرار المادية والمعنوية، بحيث يشعر كل فرد فيه أنه إلى جانب الحقوق التي له أن عليه واجبات للآخرين وخاصة الذين ليس باستطاعتهم أن يحققوا حاجاتهم الخاصة وذلك بإيصال المنافع إليهم ودفع الأضرار عنهم.
فهو في الأساس التزام الأفراد بعضهم نحو بعض، "وهو لا يقتصر في الإسلام على مجرد التعاطف المعنوي من شعور الحب والبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يشمل أيضًا التعاطف المادي بالتزام كل فرد قادر بعون أخيه المحتاج ويتمثل فيما يسميه رجال الفقه الإسلامي بحق القرابة وهو التزام المسلم الغني بالإنفاق على قرابته الوثيقة من الفقراء كأصوله وفروعه حيث يعتبرونه جزءًا منه ويلتزم شرعا بهم، ومن ثم فإن إنفاق الفرد على أولاده وأحفاده أو والديه أو إخوته الفقراء لا يعفيه من أداء الزكاة وذلك أن دفع زكاته إلى قرابته الوثيقة ممن يعتبرون جزءًا منه، يعتبر كأنه دفعها إلى نفسه فلا تجزيه، وهو إن أسقط عنه حق القرابة فإنه لا يسقط عنه حق الزكاة بخلاف القرابة البعيدة، فيفضل أداء الزكاة إليها متى كانوا محتاجين لقوله عليه الصلاة والسلام: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الحرم اثنتان صدقة وصلة"([31]).
وحق الماعون، والتزام الضيافة، والتزام الإنفاق في سبيل الله ، والأخذ بالتكافل الاجتماعي في الإسلام هومن قبيل تطبيق النص، وهو ما عبرت عنه الآية الكريمة بقوله تعالى: ) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (([32])، وقوله تعالى: ) وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (([33]) ، وقوله تعالى: ) وَيَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ(([34])، والعفو هنا هو كل ما زاد عن الحاجة، وقوله عليه الصلاة والسلام: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا" ، وتلخيصه عليه الصلاة والسلام علامة الإيمان بقوله: "والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"([35]).
نطاق التكافل الاجتماعي:
إن المجتمع المسلم هو الذي يطبق فيه الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة ونظاما وخلقا وسلوكا، وفقا لما جاء به الكتاب والسنة، واقتداء بالصورة التي طبق بها الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده.
وعندما يلتزم المجتمع بهذه القاعدة يجد التكامل الاجتماعي مكانه بارزا في المجتمع بحيث تتحقق فيه جميع مضامينه , ذلك أن الإسلام قد اهتم ببناء المجتمع المتكامل وحشد في سبيل ذلك جملة من النصوص والأحكام لإخراج الصورة التي وصف بها الرسول r ذلك المجتمع بقوله: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»([36])، لذا فإن التكافل الاجتماعي في الإسلام ليس مقصودا على النفع المادي وإن كان ذلك ركنًا أساسيًّا فيه بل يتجاوزه إلى جميع حاجات المجتمع أفرادا وجماعات, مادية كانت تلك الحاجة أو معنوية أو فكرية على أوسع مدى لهذه المفاهيم , فهي بذلك تتضمن جميع الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات داخل الأمة.
والتكافل الاجتماعي في الإسلام ليس معنيا به المسلمين المنتمين إلى الأمة المسلمة فقط بل يشمل كل بني الإنسان على اختلاف مللهم واعتقاداتهم داخل ذلك المجتمع كما قال الله تعالى: ) لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ(([37]) ؛ ذلك أن أساس التكافل هو كرامة الإنسان حيث قال الله تعالى: ) وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا(([38]).
التكافل داخل الأسرة:
لقد أكد الإسلام على التكافل بين أفراد الأسرة وجعله الرباط المحكم الذي يحفظ الأسرة من التفكك والانهيار.
ويبدأ التكافل في محيط الأسرة من الزوجين بتحمل المسؤولية المشتركة في القيام بواجبات الأسرة ومتطلباتها؛ كل بحسب وظيفته الفطرية التي فطره الله عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الرجل راع في بيته ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها»([39]).
ويأتي تقسيم وتوزيع المسؤوليات داخل البيت بين الرجل والمرأة بما يضمن قيام الأسس المادية والمعنوية التي تقوم عليها الأسرة فالله سبحانه وتعالى يخاطب أرباب الأسر رجالا ونساء بقوله: ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ (([40]) ، ولا تتم هذه الوقاية إلا بالتبصر بالحق وتعليم العلم النافع والإرشاد إلى أبواب الخير وهذا هو قوام التكافل العلمي والتثقيفي للأسرة، وهو مسؤولية مشتركة بين الزوجين فكلما وجد أحدهما في الآخر تقاعسا أو تقصيرا نبهه وأرشده إلى الصلاح والإصلاح. قال الله تعالى: )وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (([41]) ، وقد حث الإسلام على تنمية الود والحب الغريزي بين الرجل والمرأة في حياتهم الزوجية فقال تعالى: ) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (([42]).
التكافل داخل الجماعة: لقد أقام الإسلام تكافلا مزدوجا بين الفرد والجماعة فأوجب على كل منهما التزامات تجاه الآخر ومازج بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة بحيث يكون تحقيق المصلحة الخاصة مكملا للمصلحة العامة وتحقيق المصلحة العامة متضمنا لمصلحة الفرد فالفرد في المجتمع المسلم مسؤول تضامنيا عن حفظ النظام العام وعن التصرف الذي يمكن أن يسيء إلى المجتمع أو يعطل بعض مصالحه قال الله تعالى: ) وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (([43]) كما أن الفرد مأمور بإجادة أدائه الاجتماعي بأن يكون وجوده فعالا ومؤثرا في المجتمع الذي يعيش فيه قال الله تعالى: ) وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ(([44])، وقال رسول الله r «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا»
هذا التكافل لا يقف عند تحقيق مصالح الجيل الحاضر بل يتعدى ذلك إلى نظرة شاملة تضع في الاعتبار مصالح أجيال المستقبل, وهو ما من شأنه أن يسهم في حل كثير من الأزمات المعاصرة ويحاصر كثير من الأخطار التي تواجه مستقبل البشرية والتي نشأت من جراء لهاث هذا الجيل وراء مصالحه دون اعتبار للمستقبل البشري العام, وهي أخطار ومشكلات كثيرة لعل من أخطرها مشكلة البيئة والموارد الطبيعية، قال تعالى: ) وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا (([45]).
رعاية حق الجار: ومن مظاهر التكافل في الإسلام أيضا رعاية حقوق الجوار فقد أكد الإسلام على البر بالجار وصلته وكف الأذى عنه وإيصال الخير إليه، قال تعالى: ) وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ (([46])، وقال رسول الله r : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره»([47])، وقال: «والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: (الذي لا يأمن جاره بوائقه) »([48]), وحدد حقوق الجار فقال: «إن مرض عدته وإن أصابه خير هنأته وإن أصابته مصيبة عزيته ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها وإن اشتريت فاكهة فأهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده»([49]).
كفالة الفقراء والمساكين:
إن النصوص الإسلامية ذاخرة بالحض على كفالة الفقراء والمساكين ومشاركتهم آلامهم وتنفيس الكرب عنهم وبذل العون لهم ماديا ومعنويا.
إن الإسلام في مواجهة المشكلات الاجتماعية يفرض الحد الأدنى لاستقامة الحياة وجريانها على الصلاح ثم يفتح المجال أمام التطوع والإحسان مع الترغيب فيه والحث عليه وبيان ما ينتظر صاحبه من جزاء في الدنيا والآخرة.
كفالة الصغار والأيتام:
سبق عند الحديث عن التكافل داخل الأسرة أن الإسلام يهتم بالطفولة ويلزم الآباء برعاية الأبناء وتربيتهم حتى بلوغ سن الرشد مع القدرة على استقلالهم بالمسؤولية.
فإذا فقد هؤلاء الأبناء آباءهم فإن المسؤولية تنتقل بشكل متدرج إلى الأقارب القادرين فإذا انعدموا قامت على المجتمع بأسره.
وقد ورد في الحث على كفالة الأيتام والعناية بهم ما يبعث في نفس المؤمن دافعا قويا إلى ذلك, إضافة إلى المسؤولية الواجبة والتي تطالب الدولة , ممثلة في المجتمع , بالقيام بهذه الكفالة ) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (([50]) ، ) وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ (([51]) , ) وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ (([52])، ) أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ`فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ` وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (([53])، ) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ(([54]).
وإذا تصفحنا تاريخ الإسلام وجدنا أن كثيرا من عباقرة الإسلام والمبدعين على أكثر من صعيد كانوا قد فقدوا آباءهم وهم صغار وما ذلك إلا نتاج ملموس للتوجيهات والسياسات الإسلامية في هذا الصدد والتي أصبح المجتمع يقوم بها بشكل طوعي وتلقائي حتى في الأوقات التي تتخلى فيها الدولة عن واجبها فإن هذه العناية لم تغب إذ قام بها المجتمع وأقام لها من المؤسسات الخيرية ما يلبي حاجتها.
ومن مظاهر العناية التي أولاها الإسلام للأيتام حفظ أموالهم والسعي في تنميتها والابتعاد عن كل تصرف ضار بها ) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ (([55])، ) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (([56]), كما دعا إلى استثمارها والإنفاق عليهم)وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ(([57])، ) وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا(([58]) .
الإسلام دين الضمان والتكافل الاجتماعي:
إن الإسلام هو دين الضمان الاجتماعي من حيث التزام الدولة، وهو دين التكافل الاجتماعي من حيث التزام الأفراد، ويتمثل الضمان الاجتماعي في الإسلام في ضمان "حد الكفاية" لكل فرد يتواجد في مجتمع إسلامي أيا كانت ديانته وأيا كانت جنسيته تكفله له الدولة الإسلامية عن طريق مؤسسة الزكاة، وذلك متى عجز أن يوفره لنفسه لسبب خارج عن إرادته كمرض أو عجز أو شيخوخة ... إلخ، ثم يأتي التكافل الاجتماعي من جانب الأفراد، كعنصر مكمل لالتزام الدولة وجهودها في إزالة العوز والقضاء على القهر.
إننا نرى أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية إنما تكمن فيما يقرره الإسلام من ضرورة التعاون بين الدولة والأفراد، وأن لكل منهما مجاله بحيث يكمل كل منهما الآخر، والواقع أن الدولة لا تستطيع القيام بكل شيء، وأن تدخلها المطلق أو إحجامها المطلق، يؤدي إلى مساوئ عديدة، والمناط في الاقتصاد الإسلامي هو تحقيق التعاون والتكامل بين الدولة والأفراد على الوجه السابق بيانه([59]).
الوظائف الأساسية للمجتمع العام :
من خلال ما سبق يمكن تصوير الوظائف الأساسية للمجتمع في النقاط التالية :
(أ) ـ تأمين الشروط الأساسية للحياة المادية ؛ فمن حق كل من يعيش في مجتمع أن يلقي من الرعاية والحماية والتكافل ما يمكنه من الاستمرار في الحياة ، والإسلام أول دين شرع القتال من أجل الفقير ، وأخذ حقه من الغني ، وعلى الدولة أن تضع نصب عينيها تحقيق الكفاية من ضرورات الحياة ، ومن التعليم والتدريب والصحة وإيجاد فرص العمل لمواطنيها ، واتخاذ كل التدابير لتأمين ذلك ، وعلى كل القادرين في المجتمع أن يساعدوها في تحقيق هذه الأهداف ، وإن المجتمع الذي لا يقوم بالحد الأدنى من حاجات أفراده هو مجتمع مريض.
(ب) ـ توفير شروط الحياة المعنوية والروحية ، إذ من حق المسلم على مجتمعه أن يجد فيه الحرية والحفاظ على الحقوق ودفع الظلم وتكافؤ الفرص والنصح والتوجيه ، وتأمين كل ما يحفزه ، ويساعده على القيام بأمر الله عز وجل.
(ج) ـ تنظيم الطاقة الحيوية للفرد من خلال وسائله في ضبط أفراده ورقابته عليهم، بمعنى أن يحول المجتمع الفرد من شخص غرائزي يجري خلف شهواته ومصالحه إلى شخص مكيَّف يمارس حرياته ، ويصرف طاقاته ويؤمن مصالحه ضمن القواعد التشريعية والأخلاقية والسلوكية التي يحددها مجتمعه.
( د ) ـ إدارة التكامل ، وحل التوترات التي تحدث بين المكونات المختلفة للحياة الاجتماعية؛ حيث إن حياتنا تخضع لنظم عقائدية وتربوية وتعليمية واقتصادية متعددة ؛ ومن ثم فإن المتوقع حدوث نوع من الخلل والتصادم في علاقة هذه الأنساق بعضها ببعض مما يؤدي إلى تشويه الشخصية الاجتماعية وفقدها للتوازن ، ومن واجب المجتمع إدارة تلك التوترات ، والتخفيف منها بقدر الاستطاعة ، ولا يستطيع مجتمع أن يفعل شيئاً ذا قيمة من كل ما سبق ما لم يعتمد في تعامله أسلوب المفاتحة والنقد والمراجعة ، وقبل ذلك الشفافية والرحمة وتطبيق العدالة المطلقة([60]).
*****
6 ـ النصيحة في الدين ودورها في تنمية المجتمع:
الواجب على المسلمين فيما بينهم التناصح والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه كما قال تعالى: ) وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ(([61])، وقال سبحانه: )وَالْعَصْرِ ` إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ` إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (([62])، وقال النبي الكريم r : «الدين النصيحة " قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم »([63]).
هاتان الآيتان مع الحديث الشريف كلها تدل على وجوب التناصح والتعاون على الخير والتواصي بالحق، فإذا رأى المسلم من أخيه تكاسلا عما أوجب الله عليه، أو ارتكابا لما حرم الله عليه وجب نصحه وأمره بالمعروفونهاه عن المنكر حتى يصلح المجتمع ويظهر الخير ويختفي الشر كما قال الله سبحانه وتعالى: ) وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (([64])، وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان »([65])
إن المجتمع - كما يقول مالك بن نبي - الذي يعمل فيه كل فرد ما يحلو له ليس مجتمعاً ولكنه إما مجتمع في بداية تكونه وإما مجتمع بدأ حركة الانسحاب من التاريخ فهو بقية مجتمع.
واليهود حين أرادوا تدمير المجتمعات الغربية خططوا لتضخيم جانب الفردية على حساب الحس الجماعي حتى كثرت القضايا التي يعدها العرف هناك خصوصيات تخضع بمزاج الفرد ومصلحته، وكانت النتيجة التي انتهوا إليها تفكك تلك المجتمعات على نحو مخيف ذهب بأمن الحياة وروائها وسيعصف بكل الجهود العزيزة التي بذلت في بناء الحضارة الحديثة في يوم من الأيام.
وقد انتقلت هذه العدوى إلى بلاد المسلمين فصار كثير من المسلمين غير مستعد لقبول نصيحة من أحد بحجة أن ما يلاحظ عليه يعود إلى خصوصياته التي لا تقبل أي نوع من التدخل. وهذا الصنف من الناس - وهو يمثل اليوم في المسلمين الأكثرية - على غير دراية بفلسفة هذا الدين في إقامة المجتمعات وإنشاء الحضارات مما يجعل رؤيتهم للحياة كثوب ضم سبعين رقعة مختلفة الأشكال والألوان.
وبإمكان المسلم من خلال نظرة سريعة في بعض النصوص أن يتعرف وجهة الشريعة في هذا، وإليك حديث السفينة الذي وضع النقاط على الحروف في هذه المسألة بصورة مدهشة، فقد روى النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي r : «مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً»([66]).
إن هذه السفينة تمثل المجتمع الإسلامي الذي توحدت عقائده وتوحد اتجاه سيره وتوحدت غاياته والمخاطر والتحديات التي تواجهه، وإن القائم في حدود الله تعالى هو تلك الفئة الصالحة الملتزمة بشرع الله الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر، وإن الواقعين فيها هم أولئك الذين ينتهكون حرمات الله من ترك الواجبات والوقوع في المحرمات، والحديث يقرر أن ما يتوهمه بعض الناس من خصوصياته ليس كذلك كما أن الذين احتلوا أسفل السفينة كانوا واهمين في ظنهم أن لهم الحرية الكاملة في التصرف في أرض السفينة ، وذلك لأن تصرفهم فيها بخرقها يمس مصالح الذين فوقهم بل مصائرهم([67]).
ومن ثم وجب الأخذ على أيدي العصاة وعدم مداهنتهم وملاينتهم؛ لأن المعصية حين تشيع في الناس يستوجبون نزول العقوبة وذهاب الريح، ولا تشيع الفاحشة إلا حين يغض المجتمع الطرف عنها وطالما أجهض الجهد الإنساني الضخم في إعمار الأرض بسبب التقصير في جانب العبودية لله تبارك وتعالى وشواهد الماضي والحاضر ناطقة بذلك، وكيف لا والله تعالى يقول: ) وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابِ (([68]) ، وكيف لا والرسول r يقول مجيباً لمن سأله: أنهلك وفينا الصالحون؟ : «نعم إذا كثر الخبث»([69]).
واستحق بنو إسرائيل اللعن في كتاب الله على ألسنة أنبيائهم؛ لتركهم التناصح والأمربالمعروف، كما قال جل وعلا: ) لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ` كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ(([70])، فحق عليهم - بعدم التناصح، وراحة النفس بالجريمة التي يعملها الآخرون - أن وجب عليهم لعن الله، وهو الطرد من رحمته جل وعلا.
والعصيان والاعتداء جريمة؛ لأن في ذلك مجاوزة لحدود الله التي حد لعباده، وأعظم الجرائم عصيان الله في أمره، والاستكبار على شرعه، كما فعل إبليس- لعنه الله- حيث أخرجه ذلك من رحمة الله واستحق مقته وغضبه إلى الأبد، فأعظم بها من خسارة، قال ابن كثير في تفسيره: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي، نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم »([71]) قال يزيد، وأحسبه قال: «في أسواقهم، وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال: لا والذي نفسي بيده، حتى تأطروهم على الحق أطرا » وفي رواية ابن مسعود رضي الله عنه: «كلا والله لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطرا، أو تقصرنه على الحق قصرا "([72]).
فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأسس المتينة، التي تقي المجتمعات من الجريمة، وبهيمنة الرجال العارفين لما يدعون إليه المدركين حقيقة ما ينهون عنه بحكمة وموعظة حسنة يمكن بتوفيق من الله، وبالنية المخلصة، والصدق في القول والعمل - حماية للأمة من تسلط فئة نبت الشر في قلوبهم، وفقدوا هيمنة الرقابة الذاتية لنقص إيمانهم، والرقابة الأسريةلعدم توجيههم وقت التهيؤ الذهني، والاستعداد العقلي للقبول؛ لأن أمثال هؤلاء في المنزلة الثالثة، بحيث تردعهم السلطة، وتؤثر فيهم التوجيهات، وتخوفهم الجزاءات الملائمة معهم، ذلك أن سلطة الآمرين بالمعروف، والناهين عن المنكر يجب أن تكون مستندة إلى قاعدة صلبة من الإيمان، الذي يملأ النفس بحرارة اليقين، ويمدها بالشحنات الدافعة إلى العمل، كما يجب أن تدعم بالسلطة الشرعية، لينزجر المعاندون، ويقمع المكابرون، ويجازى المتجاوزون المصرون؛ لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه.
لقد جعل الله جل وعلا في شرائع دين الإسلام، وفي كل أمر ونهي حكمة بالغة، تنصلح بها الحياة في كل زمان ومكان، فالزواجر والحدود التي شرعها الله، ونظمتها تعاليم الإسلام، ليست إلا وقاية للمجتمع من تسلط فئة على فئة، وحماية لأفراده وأمنه من أصحاب النزعات الشريرة، أو الإغراءات المادية.
ولما كان الدين النصيحة والتوجيه، فإن الفرد مسئول بأن يكون عينا تراقب الأضرار؛ للتنبيه عليها والتساند مع الجهات المعينة في إنكار المنكر، والترغيب في المعروف، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم »([73]).
فنصح العامة يتم بالتوعية والتنبيه على الأخطاء برفق ولين؛ لأن الثمرة لا تتم إلا بهما، أما إذا خيف اتساع النطاق، واستمراء الباطل، فيجب على الجهة المعنية أخذهم على الحق بالقوة([74])؛ لأن الأمن حين يضطرب حبله لا يضطرب على الطالحين وحدهم، وإن الأسعار حين تغلو لتفوق طاقة الناس لا ترتفع بالنسبة للطالحين فقط، وإن العدو حين يستبيح الحمى لا يستثنى أحداً وهكذا ...!
وإذا كان أصحاب الأهواء والشهوات لا يبصرون أكثر من مواقع أقدامهم ولا يعبأون بحاضر ولا مستقبل فإن على المجتمع أن يتحمل المسؤولية تجاه حاضره ومستقبله وآخرته.
(1) ـ د. نبيل رمزي : علم اجتماع المعرفة، ط/1 ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، ص 95.
(1) ـ د. عبد الكريم بكار : مدخل إلى التنمية المتكاملة ـ رؤية إسلامية ، ط/1 دار القلم ، دمشق ، 1999م، ص 241 ـ 246، بتصرف.
(1) ـ سورة الحج الآية 30 .
(2) ـ سورة الحج الآية 32.
(3) ـ د. محمد بن سعد الشويعر: الوقاية من الجريمة في التشريع الجنائي الإسلامي، بحث بمجلة البحوث الإسلامية الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، عدد (29) ، ص150 ـ 152.
(1) ـد. محمد عثمان الخشت : المجتمع المدني ، سلسلة الشباب العدد (8) الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 2004م، ص 11.
(2) ـ د. محمد عثمان الخشت : المجتمع المدني ، مرجع سابق ، ص 6.
(3) ـ المرجع السابق ، ص 12 ـ 13.
(1) ـ المرجع السابق ، ص 16.
(2) ـ انظر: ابن بطوطة : تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ، تحقيق : د. علي منتصر الكتاني ، ط/4 مؤسسة الرسالة ، بيروت 1405هـ ، (1/118).
(1) ـ د. محمد عثمان الخشت : المجتمع المدني ، ط/1 سلسلة الشباب ، سلسلة نصف شهرية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة ، العدد (8) ص27 ـ 30.
(1) ـ د. محمد عثمان الخشت: المجتمع المدني ، مرجع سابق ، ص77 ـ 80 بتصرف.
(1) ـ رواه البخاري(1470) ، والنسائي (2589)، ومالك في الموطأ(2/998)، وأحمد (7490)، وابن زنجويه في الأموال(2080).
(2) ـانظر في تفصيل ذلك: د. محمد شوقي الفنجري: الإسلام والتأمين ، طبعة سنة 1979م، لناشره عالم الكتب بالقاهرة والرياض، ص21 وما بعدها، وكتاب : التوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول له أيضاً ، ص 71.
(1) ـ سورة البقرة الآية 272.
(2) ـ سورة آل عمران آية: 92.
(3) ـ سورة الحج آية: 77.
(4) ـ سورة آل عمران آية: 115.
(5) ـ سورة البقرة آية: 280.
(6) ـ رواه مسلم (1631) ، وأبو داود (2880) ، والترمذي(1376) ، والنسائي(3651) .
(7) ـ رواه البخاري (2737) ، ومسلم (1633) ، والترمذي (1375) ، والنسائي (3597) ، وأبو داود (2878) ، وابن ماجه (2396) ، وأحمد (2/55) .
(8) ـ ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري ، محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة - بيروت، 1379هـ، (5/402).
(9) ـ رواه الترمذي (3703) ، والنسائي (3608) .
(1) ـ رواه البيهقي في السنن الكبرى (6/265)برقم(11896).
(1) ـ انظر : أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي : حجة الله البالغة ، تحقيق: السيد سابق ، ط/1 ، دار الجيل، بيروت - لبنان1426 هـ - 2005م ، (2 / 180) .
(2) ـ سورة المائدة الآية 2 .
(1) ـ أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية للكبيسي (1 / 138) .
(2) ـ المرجع السابق (1 / 138) .
(1) ـ د. عبد الله بن أحمد الزيد: أهمية الوقف وحكمة مشروعيته ، بحث بمجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، عدد 36 ، ص 208 ـ 211.
(1) ـ د . بدر بن ناصر البدر: الوقوف على القرآن، مقال بمجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، عدد 77، ص162.
(2) ـ رواه النسائي (2582) ، وابن ماجه (1844) ، وأحمد (16227) ، والطبراني في الكبير(6212)، وقال الألباني: صحيح.
(3) ـ سورة الحجرات آية: 10.
(4) ـ سورة البقرة آية: 195.
(1) ـ سورة البقرة آية: 219.
(2) ـ محمد شوقي الفنجري: التوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول ، وزارة الأوقاف، ص 72 ـ 74.
(3) ـ رواه مسلم (2586) ، وأحمد (18373) ، والطبراني في الكبير (21/124) ح (150).
(4) ـ سورة الممتحنة آية: 8.
(5) ـ سورة الإسراء آية:70.
(1) ـ رواه البخاري(893)، (2409)، ومسلم(1829)، وأبو داود(2928)، والترمذي(1705).
(2) ـ سورة التحريم آية:6.
(3) ـ سورة التوبة آية: 71.
(4) ـ سورة الروم آية: 21.
(5) ـ سورة التوبة آية: 71.
(6) ـ سورة المائدة آية:2.
(1) ـ سورة الحج آية: 40.
(2) ـ سورة النساء آية:36.
(3) ـ رواه البخاري(6019) ، ومسلم(47) ، ومالك في الموطأ(2/929)ح(22)، الطبراني في "الأوسط" (8841).
(4) ـ رواه مسلم (46) ، والطيالسي في مسنده(1437) ، وأحمد(16372).
(5) ـ رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق(247) ، والبيهقي في شعب الإيمان(9113)،
(6) ـ سورة الضحى آية: 9.
(1) ـ سورة النساء آية: 36.
(2) ـ سورة البقرة آية : 177.
(3) ـ سورة الماعون :1 ـ 3.
(4) ـ سورة الأنفال آية: 41.
(5) ـ سورة الأنعام آية:152، والإسراء:34.
(6) ـ سورة النساء آية: 10.
(7) ـ سورة البقرة آية : 220.
(8) ـ سورة النساء آية :5.
(1) ـ د.محمد شوقي الفنجري: الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول، وزارة الأوقاف ، ص 74 ـ 75.
(1) ـ د. عبد الكريم بكار: مدخل إلى التنمية المتكاملة ، ص245 ـ 246.
(1) ـ سورة المائدة آية:2.
(2) ـ سورة العصر الآيات :1 ـ 4.
(3) ـ رواه مسلم (55) ، والنسائي (4197)، وأبو داود (4944) ، وأحمد (4/102).
(4) ـ سورة التوبة الآية 71.
(5) ـ رواه مسلم (49) ، والترمذي (2172) ، والنسائي (5009) ، وأبو داود (1140) ، وابن ماجه (1275) .
(1) ـ رواه البخاري(2493) ، والترمذي (2173) .
(2) ـ د. عبد الكريم بكار: في إشراقة آية ) كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ( ، مقال بمجلة البيان ع. 23، ص48. تصدر عن المنتدى الإسلامي.
(3) ـ سورة الأنفال آية: 50.
(4) ـ رواه البخاري (3346) ، (7059)، ومسلم (2880) ، والترمذي (2187).
(5) ـ سورة المائدة آية: 78 ، 79.
(1) ـ رواه الترمذي (3047) ، وأبو داود (4336) ، وابن ماجه (4006) .
(2) رواه أبو داود(4336).
(3) ـ رواه مسلم (55) ، والنسائي (4197) ، وأبو داود (4944) ، مسند أحمد بن حنبل (4/102).
(4) ـ د. محمد بن سعد الشويعر: الوقاية من الجريمة في التشريع الجنائي الإسلامي، بحث بمجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، عدد (29) ، ص153 ـ 154.
إن تنمية مجتمعاتنا وإصلاحها ودعمها والدفاع عنها هو مطلب شرعي أولاً ، وهو استثمار طويل الأجل ثانياً حيث يتوفر المناخ الآمن الصالح للعيش الكريم وتفتح الشخصية ونموها .
ولكي يتضح لنا مفهوم تنمية المجتمع علينا أن نعرض لبعض المفاهيم ذات الصلة الوثيقة بالمجتمع والتنمية ، والتي منها:
1 ـ إن المجتمع في جوهره تعبير إنساني عن مجمل العقائد والمفاهيم والأعراف والعلاقات والمصالح التي تسود رقعة مكانية معينة ، وتخضع لها مجموعة بشرية محددة .
2 ـ إن للعقيدة دوراً مهماً في تحديد ماهية الفعل الاجتماعي ؛ إذ إنها تحدد اتجاهه، كما أنها تفسره ، وتظهر مسوغاته ، وتكشف عن منطقيته ، كما أنها تحدد أهدافه ، وترشد إلى كثير من نظمه ووسائله([1]).
3 ـ إن كثيراً من النظريات التي حاولت الكشف عن السلوك الاجتماعي تمت في الغرب ، وعلى أسس وأصول ، وفي إطار مفاهيم وافتراضات غربية ، ولذا فإن تلك الدراسات والكشوفات قد تفيد المجتمعات الغربية لأنها خرجت من رحم ثقافتها ، لكنها تبدو قاصرة إذا طبقت على مجتمعاتنا الإسلامية .
إن فهم واقعنا على نحو جيد يتطلب معايشة ممتازة له من خلال دراسات وتقنيات خاصة وكثيفة ، وفي إطار مفاهيم ومعطيات إسلامية ومحلية ، ولابد إلى جانب ذلك أن نكون قادرين على التحرر من كثير من العادات والتقاليد والتراكمات التي شكلت رؤيتنا للحياة بعيداً عن المنهج الرباني .
4 ـ للفكر دور مهم في بناء المجتمعات ، وفي تغييرها ؛ إذ إنه يوفر لنا الأدوات التي تمكننا من استيعاب الواقع الاجتماعي ، حيث يستحيل التعامل مع أي واقع اجتماعي إلا من خلال تكوين صورة ذهنية عنه ، والفكر هو الذي يشكل هذه الصورة .
غير أن الأفكار تبقى محدودة القيمة على الصعيد الاجتماعي العملي ما لم تحدث تغييراً في مؤسسات المجتمع ونظمه ، وعلى سبيل المثال ، فإنه إذا ساد المجتمع نوع من الخوف من المستقبل وعدم الاطمئنان إليه ، فإن الحل لا يكمن في دعوة الناس إلى الاطمئنان ، وإنما في إنشاء أوضاع اجتماعية يشعر معها الناس بالأمن عن طريق تقوية الإيمان بالله ، ورحمته بخلقه ، وعن طريق تدعيم العلاقات الاجتماعية والقرابية ، وإنشاء بيوت لرعاية كبار السن ، وتكفل الدولة بضمان الحد الأدنى من العيش الكريم لكل مواطن.
5 ـ إن من المهام الأساسية للتنمية الاجتماعية دعم العلاقات الاجتماعية ، علاقات الأخوة والقرابة والجوار والزمالة والضيافة ، وتنمية مفاهيم التقدير والتسامح والفهم المتبادل ، وهذا ما تفعله كل التعاليم والآداب الإسلامية التي تهدف إلى تقريب الناس بعضهم من بعض ، ومن ثم فإن هذه المسألة يمكن أن تكون معياراً مهماً لمدى التقدم الذي يحدثه أي مجتمع مسلم([2]).
إن المجتمع العام يتألف سياسياً واجتماعياً من الأسرة ، والمجتمع المدني ، والدولة (الحكومة) ، وكل له دوره المنوط به في التنمية الاجتماعية ، وسنعرض هنا بشيء من الإيجاز لدور كل واحد منها في هذه التنمية.
1 ـ الأسرة ودورها في التنمية:
يمثل البيت المسلم إحدى الدعائم الأساسية في بناء الشخصية الإسلامية إذ هو المحضن الأول للطفل والمقر الدائم لحياة الفرد، وما دامت المدرسة في تعليمها إنما تنطلق من عقيدة الأمة وأهدافها وثقافتها وتاريخها وكل جوانب المعرفة وروافد العلم التي تتضافر على تكوين الشخصية المسلمة، فإن دور البيت ينبغي أن يكون دوراً أساسياً لمساعدة وتدعيم كل المعارف والحقائق التي يتلقاها الفرد في المدرسة فتسير معها في اتجاه واحد يحقق التعاون والانسجام، وإذا كانت المدرسة تمثل الجانب النظري في الإعداد، فإن البيت ينبغي أن يكون محلاً للتطبيق العملي لما يتلقاه الفرد في المدرسة، ويزيد في تبصيره بكثير مما تعجز المدرسة عن تغطيته، فإذا تحقق هذا التلاحم بين البيت والمدرسة كان لذلك أثره البعيد في تكوين الفرد وصلاحه واستقامة سلوكه، أما إذا حصل أي تناقض أو اختلاف بين ما يأخذه الطالب في المدرسة، وما يمارسه في البيت أو يشاهده في المنزل، فإن ذلك يورث اهتزازاً في القيم، وتذبذباً في النفس، وازدواجية في التفكير، وبالتالي يحدث خللا في بناء الشخصية وتكوينها وتقل تطلعاتها.
والأسرة عندما يدرك أفرادها ما يجب عليهم فهمه من نصوص شرعهم، ودلالات دينهم، ويحرصون على ذلك عملاً، فإن نتيجة ذلك الالتزام بالأخلاق، ومراقبة الأعمال لتزنها من منطلق الفهم الصحيح، حتى توجه الأبناء منذ حداثة أعمارهم التوجيه السليم، وتغرس في نفوسهم حب الفضيلة لفضلها، وعمق أثرها، وكراهية الرذيلة لسوئها، وآثار نتائجها؛ لأن الرذيلة يتمثل فيها شبح الجريمة التي يحسن بالأسرة تجسيمها لدى الناشئة، وإيصاد الطرق المؤدية إليها؛ ليكبر هذا الإحساس معهم، فيرونها شبحاً مخيفاً، وعملاً رذيلاً، تكبر أحاسيسهم حياله مع الأيام، حتى إذا كبروا، وصاروا في موطن المسئولية، وعمق الفهم، أدركوا بالدليل الشرعي سر ما رسخ في قلوبهم، ودور ما أنشئوا عليه من أعمال وأفكار، حيث أدرك ذلك المفهوم التربوي الشاعر العربي في قوله:
وينشأ ناشئ الفتيان منا ... على ما كان عوده أبوه
وأسوة المسلمين في ذلك منهج الصحابة، وفهم التابعين في حسن توجيههم لأبنائهم، وتلقينهم الفضيلة طبعاً وخلقاً وتعويدهم الأعمال الحميدة ترويضاً ومتابعة، حيث تابعوا التطبيق مع أقرب الناس إليهم، ونشئوا محبين لكل عمل مستحسن، آلفين كل منهج سليم، سائرين على الفطرة السليمة، التي هي تعاليم الإسلام الصحيحة؛ لأن كل مولود يولد على الفطرة، والإسلام وتشريعاته هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فالأسرة المسلمة في كل عصر ومصر عندما يهتم أربابها بأبنائهم تربية وحسن خلق، وإنكارا للمنكر، وتحذيرا من الصغائر، التي حذر منها رسول الله r بقوله: «إياكم ومحقرات الذنوب » أي ما تحتقره النفس ويصغر في العين، فإن هذا من أسباب توفر البيئة الصالحة ؛ لأن صلاح الأحداث، وتعظيمهم شرائع الله، والوقوف عند حدوده، دافعه الزاجر الإيماني، والتربية السليمة التي حرصت الأسرة على تمكينه في جوانب البيت، ضمن التربية الأولية التي يلقنها الآباء والأمهات لأبنائهم، فالكبير يمتثل ويوجه ويضرب النموذج الصالح بالقدوة والالتزام، أما الصغار فيبين لهم أن ذلك العمل ما هو إلا استجابة لشرع الله الذي جاء به الإسلام تربية وتوجيهاً وتعليماً وتطبيقاً.
فالصغير عندما يتعود ذلك عملاً، وتنطبع به أخلاقه سلوكاً، فإن الأمر سيعظم في قلبه، والمصدر الذي جاء منه وهو كتاب الله، وسنة رسوله r ، الذي استجاب من أجلها، سيكون له مكانة راسخة في أعماقه؛ لأن هذا من تعظيم حرمات الله، كما قال تعالى: ) ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ (([3])، وقوله سبحانه: ) وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (([4]).
إن الأسرة التي تحرص على غرس الروح الإيمانية في قلوب أبنائها، منذ تفتح براعمهم، فإنما تحصنهم لمجابهة الحياة، والاستعداد لإدراك المخاطر؛ لأنالإيمان بالله وبكتبه وبملائكته وبرسله، وباليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، ترسيخ هذا الإيمان يعطي الأبناء سلاحاً قوياً يدفعهم للعمل، وينمي عندهم بغض الشر، وإدراك خطره، ويحبب إليهم الخير، ويرغبهم في البحث عن مداخله، والاستئناس بأهله؛ لأن من شب على شيء شاب عليه، وبذلك يسلم الأحداث- بتوفيق من الله- من الجنوح في صغرهم، ومن ثم الابتعاد عن الجريمة في كبرهم؛ لأنها لم تجد في قلوبهم باباً مفتوحاً، ولا ارتياحاً يدفعها للاستقرار.
ومعلوم أن من يركب مخاطر اليم، إذا لم يكن قادراً على السباحة، فإنه يعرض حياته للموت، ونفسه للخطر، بل أبسط ما يقال عنه: إنه قد ألقى بنفسه إلى التهلكة؛ لأنه لم يستعد من قبل بما يعينه على مصارعة الأخطار، والقدرة على توقي أضرارها([5]).
*****
2 ـ المجتمع المدني ودوره في التنمية:
المقصود بالمجتمع المدني : " النقابات ، واتحادات العمال، والمؤسسات والهيئات والجمعيات الخيرية، والنوادي ، ومجموعة المنظمات غير الحكومية ، والغرف التجارية ، والاتحادات المهنية التي يربط بين أعضائها رباط اجتماعي ليس قائماً على القرابة أو الدين... ويكون الترابط والتضامن فيها قائماً على الوعي وتبادل الاحتياجات والمواقف في الأزمات مثل العجز أو المرض أو الوفاة أو حالات الاعتداء([6]) .
وللمجتمع المدني جانب سياسي لأنه هو البنية التحتية للحياة السياسية وهو سبب نشوئها واستمرارها الشرعي ، بمعنى أن " المجتمع المدني هو الأصل والأساس العقلي لأية شرعية سياسية وهو المسئول عن سلامة أو فساد الحياة السياسية ، فإذا كانت الديمقراطية مزيفة ، والناس سلبيين غير عابئين بما يحدث ، وغير مشاركين في الحياة السياسية فإن هذا يرجع غالباً إلى عدم سلامة وفعالية البنية التحتية للحياة السياسية أعني المجتمع المدني"([7]).
إن المجتمع المدني هو ـ أو هكذا ينبغي أن يكون ـ المساحة الحرة والمنظمة بين الأسرة والدولة ، وهو مجتمع مفتوح حر ومنظم بشكل ذاتي ، وليس بشكل خارجي أو قهري ، أي ليس منظماً من قبل الدولة ، بل منظماً تنظيماً داخلياً بواسطة أعضائه والقوانين التي وضعوها بالأسلوب الديمقراطي ، وارتضاها المجتمع العام ، ويربط بين الناس بروابط ثقافية أو اجتماعية أو مهنية أو سياسية أو اقتصادية ، أو أية رابطة مدنية أخرى تقوم على العمل التطوعي، والإرادة الحرة وتبادل المصالح المستنيرة المشتركة([8]).
أركان المجتمع المدني :
يقوم المجتمع المدني على ثلاثة أركان :
(1) ـ الإرادة الحرة : فالمجتمع المدني يقوم على الانتماء التطوعي الحر بملء الرغبة وكامل القناعة الذاتية بناء على وعي اجتماعي وسياسي .
(2) ـ التنظيم : فكل جمعية أو هيئة أو رابطة في المجتمع المدني لها نظام ولوائح تحدد شروط العضوية ومنهج العمل داخلها كما يوجد نظام عام يحكم ويحدد العلاقات بين أجزاء المجتمع المدني ، ويحكم العلاقة بينه وبين الدولة .
(3) ـ التسامح وقبول التعددية: فالتعددية سنة كونية لا سبيل للقضاء عليها سواء على مستوى المجتمع الواحد أو على مستوى المجتمع العالمي ، وفيه يوجد قبول كامل لهذه التعددية واعتراف بها وتسامح تجاه ما ينتج عنها من اختلافات ، كما أن لديه التزام أخلاقي بالإدارة السلمية للاختلافات عندما يحدث صراع([9]).
المبادئ التي يقوم عليها المجتمع المدني:
يقوم المجتمع المدني على مجموعة من المبادئ أهمها ما يلي:
1 ـ المساواة المستنيرة . 2 ـ حماية الجماعات الضعيفة والأقليات.
3 ـ الحرية والاستقلال الفردي . 4 ـ التناول الديمقراطي للسلطة .
5 ـ مشاركة الحكومة في التنمية . 6 ـ الشفافية والرقابة المتبادلة .
أنماط من تنظيمات المجتمع المدني في الحضارة الإسلامية :
عرف المجتمع المدني في الحضارة الإسلامية أشكالاً متعددة مما نطلق عليه الآن اسم مؤسسات المجتمع المدني مثل الأوقاف وطوائف الحرف والتجار والأخويات .
ويشكل نظام الأوقاف لبنة أساسية للتكافل الاجتماعي بعيداً عن دور الدولة ، وكانت الأوقاف تلعب دوراً كبيراً في بنيان الأمة أو المجتمع المدني حيث كانت تساهم في التوازن الاجتماعي والاقتصادي فهي خدمة عامة تقدم للناس ابتغاء وجه الله تعالى، وكانت الأوقاف متنوعة فهي تشمل كافة الخدمات من إصلاح الطرق العامة وإنشاء الجسور وعمارة المساجد وتقديم الخدمات الطبية وكفالة الأيتام واللقطاء والفقراء ومساعدة طلبة العلم ومساندة المزارعين فيأخذون بذور أرضهم مجاناً ، ومساعدة صغار التجار بعطايا أو بقروض حسنة بلا فوائد وتزويج الفقراء من الشباب ذكوراً وإناثاً ، وكفالة العميان والمقعدين ، بل وتقديم الألبان للأمهات الفقيرات ، وتقديم العون لابن السبيل.
ولنأخذ إحدى عواصم الحضارة الإسلامية كنموذج للدور العظيم الذي كانت تقوم به الأوقاف في حياة الناس ، يقول ابن بطوطة : " والأوقاف بدمشق لا تحصر أنواعها ومصارفها لكثرتها فمنها أوقاف على العاجزين عن الحج تعطى لمن يحج عن الرجل منهم كفايته ، ومنها أوقاف على تجهيز البنات إلى أزواجهن ، وهن اللواتي لا قدرة لأهلهن على تجهيزهن ، ومنها أوقاف لفكاك الأسارى ، ومنها أوقاف لأبناء السبيل يعطون منها ما يأكلون ويلبسون ويتزودون لبلادهم ، ومنها أوقاف على تعديل الطرق ورصفها ؛ لأن أزقة دمشق لكل واحد منها رصيفان في جنبيه يمر عليهما المترجلون ، ويمر الركبان بين ذلك ، ومنها أوقاف لسوى ذلك من أفعال الخير([10]).
أما الأخويات فهي في الأساس نظام صوفي وجد خارج نطاق المسجد فيما كان يسمى الزاوية أو الرباط أو التكية ، وكان أعضاؤها يشكلون نظاماً اجتماعياً يطلق عليه النظام الأخوي ، ومع أن الانضمام لهذا الشكل من التنظيم كان مفتوحاً لكن كان لابد من توافر بعض الشروط منها التأكد من وجود إرادة حرة ورغبة حقيقية وقناعة ذاتية.
وتطورت الأخويات فأصبحت تضم لها أفراد حرفة معينة ، أو معظمهم ، ومن ثم أصبحت تشكل قاعدة اتحاد عمال أو نقابة مصغرة ، وهو ما يمكن أن نطلق عليه : الشراكة على أساس الاهتمامات والمصالح المشتركة.
أما التنظيمات المهنية التي كانت تضم أهل كل حرفة في تنظيم واحد له مصالحه المشتركة وطرقه الذاتية في التكافل بين أعضائه فهي مسألة معروفة تماماً وهي إن لم تكن تشتمل على اللوائح والآليات الموجودة الآن لكنها ـ بلا شك ـ كانت تمثل قاعدة نقابة.
ومن أشكال المجتمع المدني كذلك ما كان يعرف ولا يزال نجده حتى الآن في مصر وفي عدد من الدول العربية نظام المضايف والمجالس العرفية ، ومجالس العرب لفض المنازعات بعيداً عن الدولة أو القضاء .
إن هذه كلها أشكال المجتمع المدني في مجتمعاتنا ينبغي الحفاظ عليها أو استعادتها ، ثم تطويرها وتحديثها عن طريق التوعية بالآليات والممارسات المعاصرة وتوسيع نطاق دورها ثم تكوين أشكال جديدة لكي تعمل بجوار هذه التكوينات التقليدية([11]).
الدور المنوط بالمجتمع المدني:
1 ـ على المجتمع المدني تبادل الرقابة والنقد والنصيحة بينه وبين الحكومة في إطار الدستور والقانون .
2 ـ على المجتمع المدني مراقبة الأمن في المجتمع المحلي الصغير بدون اعتداء على الحريات الشخصية والإبلاغ عن الحوادث التي تقع من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما أن عليه أن يقوم بنوع من الرقابة الذاتية على نفسه ضد الفساد الداخلي.
3 ـ على المجتمع المدني أن يحمي الأفراد من القوة الطاغية لبعض الجهات ذات القوة في الدول المختلفة وللنقابات ومنظمات حقوق الإنسان دور كبير في هذا الصدد .
4 ـ للمجتمع المدني دور كبير في مساعدة الحكومة في المساهمة في تقديم الخدمات العامة ، ورعاية الأيتام والمعاقين والمسنين وتقديم الخدمات العلاجية ومحو الأمية .
5 ـ على المجتمع المدني عبء كبير في مجال البيئة : أعمال النظافة في المجتمع المحلي والإبلاغ عن المصانع والورش الملوثة للبيئة ، وزراعة المناطق المحيطة بالبيوت وأمامها واستغلال المساحات الفارغة لعمل حدائق ..إلخ.
6 ـ على المجتمع المدني مساعدة الحكومة في مكافحة البطالة من خلال تقديم القروض الحسنة ، أي القروض بلا فوائد ، لتشجيع المشروعات الاقتصادية الصغيرة وعمل دورات تدريبية لنقل وتنمية المهارات الإنتاجية التي تساعد على تهيئة العاطلين للعمل ، أو تساعد الذين يرغبون في تطوير أنفسهم وتحسين مستوى عملهم أو تغيير مجاله .
7 ـ على المجتمع المدني عمل برامج فعالة وعملية لنشر الوعي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في مختلف الطبقات ولاسيما الطبقات الدنيا والتركيز على نشر ثقافة التنمية والإنتاج وتفعيل مشاركة المواطنين وتهيئة المناخ العام لجعل كل مواطن يشعر بأن أي عمل إيجابي ـ مهما كان صغيراً ـ سوف يساهم في عملية التنمية والتقدم ، وغرس مفاهيم عمل الخير الإيجابي الذي ينعكس على عملية التنمية والبناء والتعمير والإنتاج([12]).
*****
3 ـ الدولة أو الحكومة ودورها في التنمية:
مسؤولية الدولة: إذا كان الإسلام قد أعطى عناية كبيرة لوسائل التكافل الفردية فإنه لم يكتف بها بل أقام إلى جانبها الوسائل العامة التي جعلها من مسؤولية الدولة ومن واجباتها الاجتماعية.
ومن أهم هذه الوسائل:
أ- تأمين موارد المال العام:
وذلك باستثمار المحيط الطبيعي للدولة وما ينطوي عليه من ثروات باستخراج معادن الأرض وكنوز البحار وكافة الثروات التي أودعها الله في الكون واستخلف فيها الإنسان وجعله سلطانا على تسخيرها والانتفاع بها في حياته ليتحقق أقصى حد للرفاهية الاجتماعية الشاملة التي لا تقتصر على فئة دون فئة أو مجال دون آخر.
ولو أن كل دولة قامت بواجبها في هذا المجال ووزعت نتائج هذه المصادر بالقسط - خدمات عامة وفرص عمل- لأقبلت المجتمعات الإنسانية كلها على نهضة جبارة.
ب- إيجاد فرص عمل للقادرين عليه:
وذلك بالبحث عن أفضل الحلول لمواجهة البطالة وبإقامة المشاريع البناءة التي تساهم في النهضة العامة, وتوفر في ذات الوقت فرص العمل للأيدي العاطلة بعدالة تامة ومراعاة للحاجات العامة وإعطاء الأولوية للفئات الفقيرة المحرومة, ونذكر هنا تلك الحادثة التي لها دلالتها حيث جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله فأعطاه درهما وأمره أن يشتري به فأسا ويذهب إلى (تحذير رابط هكر لاتضغط عليه) فيحتطب ويأتيه بعد فترة فلما جاءه أخبره أنه وفر قدرا من المال لحاجته وتصدق بالبعض الآخر فقال r : «لأن يأخذ أحدكم حبله ويحتطب خيرا له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه»([13]).
ج- تنظيم وسائل التكافل الفردي:
فالدولة مسئولة عن تنظيم الوسائل الفردية للتكافل - سابقة الذكر- وخاصة الزكاة والوقف, وذلك بإقامة السياسات اللازمة لتحقيق أهداف تلك الوسائل المتمثلة في القضاء على الفقر وتقريب الهوة الاجتماعية بين الموسرين والمحرومين , وإيجاد الضمانات اللازمة لتحقيق ذلك.
فعندما يتعرض المجتمع لأوضاع غير عادية يصل فيها التفاوت الاجتماعي إلى حد غير مأمون وتعجز الدولة بمواردها العامة عن تلبية الحاجات الاجتماعية وعن القيام بوظائفها وواجباتها تجاه المجتمع, فلا مانع بل يجب - في رأي معظم فقهاء الإسلام - أن تفرض الدولة في أموال الأغنياء ما يحقق ذلك حتى تعود الأوضاع إلى حالتها السوية على أن تكون في ذلك قوامة بالقسط وأن تكون الدوافع الحقيقية هي خدمة الصالح العام.
الضمان الاجتماعي في الإسلام:
ويراد به التزام الدولة الإسلامية نحو كافة المقيمين بها، أيا كانت ديانتهم أو جنسياتهم، وذلك بتقديم المساعدة للمحتاجين منهم في الحالات الموجبة بتقديمها كمرض أو عجز أو شيخوخة، متى لم يكن لهم دخل أو مورد يوفر لهم حد الكفاية، ودون أن يطلب تحصيل اشتراكات مقدمًا.
والأخذ بالضمان الاجتماعي في الإسلام، هو من قبيل تطبيق النص أي ما ورد بالقرآن والسنة فيما يتعلق بالزكاة وهذا ما يميز الضمان الاجتماعي في الإسلام، عن التأمين الاجتماعي والذي يمكن الأخذ في الإسلام بموجب المصلحة، والتأمين الاجتماعي كما هو معروف تتولاه الدولة والمؤسسات الخاصة، ويتطلب مساهمة المستفيد باشتراكات يؤديها، وتمنح له مزايا التأمين أيا كان نوعها وذلك متى توافرت له شروط استحقاقها بغض النظر عن فقره أو غناه([14]).
******
4 ـ ـالأوقاف الخيرية ودورها في التنمية :
الوقف الخيري أحد أبرز سمات المجتمع المسلم، ارتبط بالوجود الإسلامي في المدينة، ومارسه المسلمون تلبية لأوامر الإسلام العقدية والتعبدية والخلقية ولحاجات الناس، حيث شمل الوقف كل جوانب الحياة وأوجه الإنفاق على دور العبادة والتعليم والخير.
أهمية الوقف وأدلة مشروعيته:
الوقف جائز ومشروع بنصوص عامة من القرآن الكريم وأخرى مفصلة من السنة.
أما الكتاب فقوله تعالى: ) وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ(([15])، وقوله تعالى: ) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (([16]) أي من الصدقات والوقف منها فهو مندوب إليه، وقوله تعالى: ) وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (([17]) ، وقوله تعالى: ) وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ (([18])، وقوله تعالى: ) وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ (([19]).
ومن السنة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله r قال: " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"([20])، والصدقة الجارية محمولة على الوقف عند العلماء، فإن غيره من الصدقات ليست جارية، بل يملك المتصدق عليه أعيانها ومنافعها.
وحديث وقف عمر بن الخطاب، فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما «أن عمر أصاب أرضا من أرض خيبر، فقال يا رسول الله: أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالاً أنفس منه، فما تأمرني، فقال: " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" قال: فتصدق بها عمر على ألا تباع ولا توهب ولا تورث، في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول"([21]).
قال الحافظ ابن حجر: "وحديث عمر هذا أصل في مشروعية الوقف"([22]).
وعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أن النبي r قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال: " من يشتري بئر رومة فيجعل منها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي"([23]).
وعن عائشة - رضي الله عنها- «أن رسول الله r جعل سبع حيطان له بالمدينة صدقة على بني المطلب وبني هاشم"([24])، وبعد ذلك تتابع الصحابة رضوان الله عليهم في الوقف.
فنظام الوقف إذن باعتباره نظاماً خيرياً موجود منذ القدم بصور شتى، إلا أنه من المؤكد أن نظام الوقف في الإسلام بشكله الحالييبقى خصوصية إسلامية لا يمكن مقارنتها بصور البر في الحضارات أو الشعوب الأخرى وهذا عائد إلى عدة أمور:
1 - التعلق الشعبي به وامتداد رواقه ومظلته إلى أمور تشف عن حس إنساني رفيع.
2 - عدم اقتصار الوقف على أماكن العبادة كما هو في الأديان السابقة، بل امتد في نفعه إلى عموم أوجه الخير في المجتمع.
3 - شمول منافع الوقف حتى على غير المسلمين من أهل الذمة، فيجوز أن يقف المسلم على الذمي لما روي أن صفية بنت حيي - رضي الله عنها - وقفت على أخ لها يهودي.
ويتميز الوقف بخصائص وميزات متعددة قد لا توجد في المشاريع الخيرية الأخرى، وهذه المزايا أكسبته تلك الحيوية التي استمر أثرها في الأمة على مدى قرون طويلة؛ لأجل ذلك لا عجب أن نرى ذلك الإقبال الكبير من لدن أفراد المجتمع المسلم على الوقف وتحبيس جزء كبير من أملاكهم لأعمال الخير، وقدوتهم في ذلك نبيهم محمد r ثم صحبه الكرام، فقد وقف مجموعة من أصحاب النبي r منهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير بن العوام ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة وصفية زوجات الرسول r وأسماء بنت أبي بكر وسعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد وجابر بن عبد الله وغيرهم، رضي الله عنهم أجمعين، ومن بعدهم من التابعين وتابع التابعين.
ثم سار من بعدهم الأغنياء والموسرون من المسلمين فأوقفوا الأوقاف وأشادوا الصروح، بنوا المساجد، وأنشئوا المدارس وأقاموا الأربطة، وهؤلاء الأخيار والأغنياء الأبرار لم يدفعهم إلى التبرع بأنفس ما يجدون وأحب ما يملكون، ولم يتنازلوا عن هذه الأموال الضخمة والثروات الهائلة إلا لعظم ما يرجون من ربهم ويأملون من عظيم ثواب مولاهم، ثم الشعور بالمسئولية تجاه الجماعة والأقربين، دفعهم ذلك كله إلى أن يرصدوا الجزيل من أموالهم ليستفيد إخوانهم أفرادا وجماعات، جمعيات وهيئات، أقرباء وغرباء.
وفي عهد العباسيين كان لإدارة الوقف رئيس يسمى (صدر الوقف) أنيط به الإشراف على إدارتها وتعيين الأعوان لمساعدته على النظر عليها.
ولما تولى العثمانيون مقاليد السلطة في معظم البلاد الإسلامية اتسع نطاق الوقف لإقبال السلاطين وولاة الأمور في الدولة العثمانية على الوقف، وصارت له تشكيلات إدارية تعنى بالإشراف عليه وصدرت تعليمات متعددة لتنظيم شئونه وبيان أنواعه وكيفية إدارته، ولا زال الكثير من هذه الأنظمة معمولا بها إلى يومنا هذا.
الحكمة من مشروعيته:
قال بعض أهل العلم: الوقف شرع لمصالح لا توجد في سائر الصدقات، فإن الإنسان ربما صرف مالا كثيرا ثم يفنى هذا المال، ثم يحتاج الفقراء مرة أخرى أو يأتي فقراء آخرون فيبقون محرومين، فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شيء وقفا للفقراء وابن السبيل يصرف عليهم من منافعه ويبقى أصله([25]).
لقد أمر الإسلام بكل ما يقوي عرى الصلة والتراحم بين المسلمين عامة ويحقق التكافل فيما بينهم، وحض على التعاون والتكاتف في كل سبل الخير والبر والمعروف، قال تعالى: ) وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (([26]) ، والوقف فيه تحقيق لكلا الغرضين، التكافل العام بين المسلمين، والتكافل الخاص في نطاق الأسرة الواحدة.
ولما كان المال محببا إلى النفوس ويصعب على المرء التفريط فيه، فقد شرع الإسلام حبس عين المال، والتصدق بمنفعتها وفي هذا تحقيق لرغبة الإنسان المتمشية مع ما جبل عليه من حرص على المال، وذلك لأن عين ماله باقية في الوقف ليس لأحد التصرف فيها.
كما أن في الوقف تحقيقا لمصالح الأمة وتوفيرا لاحتياجاتهم ودعما لتطويرها ورقيها، وذلك بما يوفره من دعم لمشروعاتها الإنمائية، وأبحاثها العلمية، وذلك أن الوقف لا يقتصر على الفقراء وحدهم وإنما يمتد نفعه ليشمل كثيرا من المجالات التي تخدم البشرية.
وإذا كان المسلم حريصا على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويرجو الثواب في الدنيا والآخرة، فإن الله سبحانه فتح أمامه أبواب الخير العديدة ومنها الوقف، إضافة إلى أن الوقف في الإسلام من أهم المؤسسات التي كان لها دور فعال في الحضارة الإسلامية لكافة جوانبها الدينية والاقتصادية والاجتماعية وحراسة الدين، ومن أهم آليات حراسة الدين بناء المساجد وعمارتها لإقامة الصلوات التي تعد عماد الدين، وكان الوقف وما يزال المصدر الرئيس لتوفير التمويل اللازم لذلك، هذا إلى جانب أن وقف الكتب وإقامة المكتبات وإقامة حلقات التعليم في المساجد تعمل في مجال حراسة الدين كما تعمل في مجال التنمية البشرية.
ويلعب الوقف دوراً هاماً في مكافحة الفقر وإنشاء المدارس والمستشفيات والطرق والجسور، ومصادر المياه الصالحة للشرب، وغيرها من مؤسسات التنمية الاجتماعية والحضارية، وظهر للوقف قديما دور في النشاط الزراعي بوقف الأراضي الزراعية واستغلالها لحساب مستحقي الوقف.
ومما يبرز أهمية الوقف أن بعض الدول غير الإسلامية والمتقدمة منها مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ينتشر الوقف بها رغم أنه ليس وراء ذلك دافع ديني إسلامي، ورغم كثرة المبتكرات لديهم من أساليب تمويل الخدمات الاجتماعية إلا أنهم أخذوا صيغة الوقف كما جاء بها الإسلام وطبقوها في مجالات عديدة مثل المستشفيات والجامعات، ومواجهة الكوارث وتقديم الإعانات للفقراء، كل ذلك يؤكد لنا أن مؤسسة الوقف ليست عملا تراثيا من الماضي ولم يعد له حاجة في الوقت الحاضر، بل على العكس دوره مطلوب بشدة الآن، وله ما يبرره ويجب العمل على إحيائه بكل السبل.
تقوم فكرة الوقف نفسها على تنمية قطاع ثالث متميز عن كل من القطاع الخاص، والقطاع الحكومي، وتحميل هذا القطاع مسؤولية النهوض بمجموعة من الأنشطة هي - بطبيعتها - تدخل في إطار البر والإحسان والرحمة والتعاون، لا في قصد الربح الفردي، ولا ممارسة قوة النظام وسطوته؛ لأن هذا النوع من الأنشطة قائم على المودة والمرحمة.
فالوقف إخراج لجزء من الثروة الإنتاجية في المجتمع من دائرة المنفعة الشخصية ودائرة القرار الحكومي معا، وتخصيص لذلك الجزء لأنشطة الخدمة الاجتماعية العامة، وقد قررت الشريعة الإسلامية أن هذه الأنشطة والخدمات هي حاجة بشرية، لا تقتصر على المجتمع الإسلامي فقط بل هي لغير المسلمين أيضا.
ويعد الوقف بمفهومه الواسع أصدق تعبيرا وأوضح صورة للصدقة التطوعية الدائمة، بل له من الخصائص والمواصفات ما يميزه عن غيره، وذلك لعدم محدوديته واتساع آفاق مجالاته، والقدرة على تطوير أساليب التعامل معه، وكل هذا كفل للمجتمع المسلم التراحم والتواد بين أفراده على مر العصور بمختلف مستوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها الأمة الإسلامية خلال الأربعة عشر قرنا الماضية، فنظام الوقف مصدر مهم لحيوية المجتمع وفاعليته، وتجسيد حي لقيم التكافل الاجتماعي التي تنتقل من جيل إلى آخر حاملة مضموناتها العميقة في إطار عملي يجسده وعي الفرد بمسؤولياته الاجتماعية، ويزيد إحساسه بقضايا إخوانه المسلمين، ويجعله في حركة تفاعلية مستمرة مع همومهم الجزئية والكلية.
إن الدارس للوقف في الحضارة الإسلامية ليعجب من التنوع الكبير في مصارف الأوقاف، فكان هناك تلمس حقيقي لمواطن الحاجة في المجتمع، لتسد هذه الحاجة عن طريق الوقف، فالوقف من حيث بعده الاجتماعي يبرهن على الحس التراحمي الذي يمتلكهالمسلم ويترجمه بشكل عملي في تفاعله مع هموم مجتمعه الكبير، ويظهر هذا جليا في رصد التطور النوعي للوقف على امتداد القرون الأربعة عشر، فقد كان المسجد أهم الأوقاف التي عني بها المسلمون، بل هو أول وقف في الإسلام، كما هو معلوم في قصة بناء مسجد قباء أول مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، ولعل من أبرز شواهد اهتمام المسلمين بذلك الجانب في الوقف: الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والجامع الأزهر بالقاهرة، والمسجد الأموي بدمشق والقرويين بالمغرب، والزيتونة بتونس وغيرها كثير، ثم يأتي في المرتبة الثانية من حيث الكثرة العددية والأهمية النوعية المدارس، فقد بلغت الآلاف على امتداد العالم الإسلامي، وكان لها أثر واضح في نشر العلم بين المسلمين، وقد أدى توافد طلاب العلم من جميع أنحاء العالم إلى مراكز الحضارة الإسلامية والعواصم الإسلامية إلى إنشاء الحانات الوقفية التي تؤويهم، مع تهيئة الطرق، وإقامة السقايات والأسبلة في هذه الطرق للمسافرين، وكذا دوابهم.
وصاحب ذلك إنشاء الأربطة ودور العلم للطلاب الغرباء لإيوائهم، واستتبع ذلك ظهور الوقف للصرف على هؤلاء الطلاب باعتبارهم من طلاب العلم المستحقين للمساعدة في دار الغربة، ولا تخلو كل هذه المراحل والأنواع من جوانب اجتماعية للوقف، إلا دلالتها وأهميتها وأثرها في المجتمع بشكل عام.
كما أن للوقف دورا فاعلا في مجال الرعاية الاجتماعية، يتمثل ذلك في المدارس والمحاضن التي أنشئت خصيصا للأيتام، يوفر لهم فيها المأكل والأدوات المدرسية، كما يتمثل دور الوقف في مجال الرعاية الاجتماعية في الأربطة بالإضافة إلى الأسبلة التي يقصد بها توفير ماء الشرب للمسافرين وعابري السبيل وجموع الناس، سواء داخل المدن أو خارجها، وقد أدت دورها الاجتماعي باقتدار رغم صعوبة استمرار مثل هذه المؤسسات الاجتماعية وبقائها فترات طويلة وعلى مدى أجيال متوالية، ويعود ذلك إلى حاجتها الكبيرة إلى موارد مالية دائمة لا تتوقف ولا تنضب، وقد تحقق لها ذلك بفضل من الله ثم بفضل نظام الوقف الذي ازدهر في تصاعد مع ازدهار الحضارة الإسلامية، ذلك أن الملاحظ في كثير من حلقات التاريخ وفي العديد من بلاد العالم توقف مؤسسات خيرية ضخمة عن أداء رسالتها بعد فترة من الزمن، بسبب نضوب مواردها المالية وإفلاسها، مما اضطرها إلى طلب مساعدة الخيرين بين حين وآخر، أما في الحضارة الإسلامية فإنه قل أن تجد مثيلا لهذه الظاهرة.
الأهداف الخاصة للوقف:
للوقف عند المسلمين عدة أهداف خيرية واجتماعية حميدة، منها ما يقصد به المجتمع ومنها ما يقصد به حماية الأسر وتلاحمها وترابطها وتعاونها على البر والتقوى بصفتها اللبنة الأولى للمجتمع ومنها ما يعود على الموقف نفسه من أجر وثواب يناله بسبب الوقف وإليك أهم أهداف الوقف:
1 - تحقيق مبدأ التكافل بين الأمة المسلمة وإيجاد التوازن في المجتمع فإن الله - سبحانه وتعالى- جعل الناس مختلفين في الصفات متباينين في الطاقة والقدرة، والوقف عامل من عوامل تنظيم الحياة بمنهج حميد يرفع من مكانة الفقير ويقوي الضعيف، ويعين العاجز، ويحفظ حياة المعدم، من غير مضرة بالغني ولا ظلم يلحق بالقوي، وإنما يحفظ لكل حقه بغاية الحكمة والعدل، فتحصل بذلك المودة وتسود الأخوة ويعم الاستقرار، وتتيسر سبل التعاون والتعايش بنفوس راضية مطمئنة.
2 - في الوقف ضمان لبقاء المال ودوام الانتفاع به والاستفادة منه مدة طويلة، فإن الموقوف محبوس أبدا على ما قصد له لا يجوز لأحد أن يتصرف به تصرفا يفقده صفة الديمومة والبقاء.
3 - في الوقف استمرار للنفع العائد من المال المحبس، فثوابه مستمر لموقفه حيا أو ميتا وداخل في الصدقة الجارية التي أخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنها من العمل الذي لا ينقطع، وهو أيضا مستمر النفع للموقوف عليه ومتجدد الانتفاع منه أزمنة متطاولة([27]).
4 - للوقف هدف أعلى وأسمى من بقية الأهداف وهو امتثال أمر الله - سبحانه وتعالى- بالإنفاق والتصدق والبذل في وجوه البر، كما في الآيات التي سبق ذكرها وغيرها من الآيات المماثلة، كما أن فيه امتثالا لأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة وحثه عليها.
5 - في الوقف تحقيق لأهداف اجتماعية واسعة وأغراض خيرية شاملة كدور العلم والوقف على طلبة العلوم الشرعية والعلوم المباحة التي تعود بالنفع على المسلمين والتي هي من متطلبات المجتمع المسلم، وما يتبع ذلك من أبحاث ودراسات تكون من وسائل تنمية المجتمع المسلم وإغنائه عما بيد عدوه.
وقد قام على الوقف جامعات علمية نشرت نورها على الأرض، وحملت رسالة الإسلام إلى الناس، وبسبب الوقف وحده نشطت في البلاد الإسلامية حركة علمية منقطعة النظير غير متأثرة بالأحداث السياسية والاجتماعية التي سادت بلاد المسلمين، فوفرت للمسلمين نتاجاً علمياً ضخماً وتراثاً إسلامياً خالداً، وفحولاً من العلماء لمعوا في التاريخ العالمي كله([28]).
فمن الوقف يمكن إيجاد مؤسسات وقفية تعمل بحرية كاملة بعيدا عن المؤثرات الخارجية تؤدي غرضا أو أغراضا متعددة تخدم المجتمع، وتساهم فينشر الإسلام وتبلغ رسالته تدعم تلك المؤسسات الوقفية من قبل من يسر الله لهم أموالا تزيد عن حاجتهم.
كما أن في تلك المؤسسات تحقيقا لغرض كثير من الأفراد الذين يرغبون في فعل الخير ولكن أعمالهم والتزاماتهم تمنعهم من ذلك أو ليس لديهم الخبرة الكافية للقيام بتلك الأعمال فإذا وجد من يخدمهم باستغلال ما ينفقونه على سبل الخير من المتخصصين في مجال الاستفادة به بما يحقق الغاية منه دفعهم هذا إلى كثرة الإنفاق لاطمئنانهم إلى أن عائد ما ينفقونه سوف يصرف في مصرفه السليم.
6 - بالوقف يمكن للمرء أن يؤمن مستقبله ومستقبل ذريته بإيجاد مورد ثابت يضمنه ويكون واقيا لهم عن الحاجة والعوز والفقر، فقد جبلت النفس البشرية على الحرص على المال وفي الوقف وسيلة مباحة لتحقيق تلك الرغبة.
7 - في الوقف وسيلة لحصول الأجر والثواب من الله تعالى وتكثيرها. كما أن فيه وسيلة للتكفير عن الذنوب ومحوها، وفي الكل تحقيق للراحة والطمأنينة النفسية في الدنيا، والفوز بنتائج ذلك في الدار الآخرة.
8 - في الوقف حماية للمال ومحافظة عليه من عبث العابثين كإسراف ولد أو تصرف قريب، فيبقى المال وتستمر الاستفادة من ريعه، ويدوم جريان أجره له.
9 - وأيضا في الوقف بر للموقوف عليه وقد حث الشرع الكريم على البر ورغب فيه ففي البر تدوم الصلة وتنقطع البغضاء ويتحاب الناس فتسمو الهمم وتأتلف القلوب وتتعاون على الأمور النافعة وتتجنب الكيد للآخرين وتتجه إلى العمل المنتج النافع. كما أن ذلك من أسباب ترابط الأسرة الواحدة وتماسكها وهي اللبنة الأولى للمجتمع.
10 - في الوقف تطويل لمدة الانتفاع من المال ومد نفعه إلى أجيال متتابعة، فقد تتهيأ السبل لجيل من الأجيال لجمع ثروات طائلة ولكنها قد لا تتهيأ للأجيال التي تليه فعن طريق الوقف يمكن إفادة تلك الأجيال اللاحقة بما لا يضر الأجيال السابقة.
11 - الحاجة ماسة إلى الوقف ففيه تحقيق لكثير من الأهداف والأغراض التي ذكرنا، وبعدمه يحرم المجتمع منها([29]).
الطرق والأساليب الداعمة للوقف:
هناك جملة من الطرق والأساليب الداعمة للوقف وإرجاعه إلى دوره الرائد في دعم الأعمال الخيرية والعلمية والاجتماعية وغيرها، للوصول إلى ما يطمح إليه الجميع بإذن الله فمن ذلك:
1 - تنفيذ حملة إرشاد وتوعية تهدف إلى إبراز قيمة الصدقات وأجر الإنفاق في سبيل الله، وبخاصة ما كان منها صدقة جارية (الوقف) للإقبال على إحياء هذا النظام وجعله يؤدي دوره.
2 - استمرار عقد الندوات العلمية المتخصصة في الأوقاف وطرحها بشكل موسع بحيث تكون المشاركات من دول العالم الإسلامي وعدم قصرها على المستوى المحلي.
3 - إبراز دور الوقف الاجتماعي في النهضة الإسلامية وطرحها عبر القنوات الإعلامية، مع التركيز على ضرورة التنوع في مصارف غلال الأوقاف وفق حاجات المجتمع كي تسد ثغراته الاجتماعية.
4 - طباعة أبحاث الندوات التي أقيمت عن الوقف في كتب وطرحها في الأسواق للبيع وعدم الاقتصار على التوزيع المجاني لها.
5 - تحويل جميع عمليات الوقف من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي منظم من خلال إنشاء صناديق وقفية متخصصة يندرج ضمنها الأوقاف القائمة حاليا، وما يستجد من أوقاف في إطار واحد تحدده شروط الواقفين.
وتخصص هذه الصناديق المقترحة للقيام بالأنشطة الشرعية والثقافية والصحية بالإضافة إلى الأنشطة الاجتماعية من خلال إنفاق ريع أموال الواقفين بما يحقق أغراضهم، وتتكون موارد كل صندوق من ريع الأموال والأعيان الوقفية ويقوم على إدارة كل صندوق لجنة متخصصة، وتساعد مثل هذه الصناديق على توفير رأس مال كبير من مجموع الأوقاف المتناثرة، مما يعطي فرصة أكثر لتنمية رؤوس الأموال وإنشاء مشاريع تحقق تنمية واسعة.
ويمكن لتلك الصناديق دعم المشاريع الخيرية التي تتوافق مع شروط الواقفين، بحيث تقوم أية جهة بتقديم مشروع متكامل من حيث الدراسة والتنفيذ ونوعية ومقدار المستفيدين منه، ليقوم الصندوق بدراسة المشروع وتحديد مدى إمكانية دعمه وفق معايير واضحة، بذلك نضمن تحقيق أكثر فائدة من الأوقاف في المجالات المختلفة.
6 - استصدار نظام للأوقاف يتضمن تعريفه، وتنظيمه، وحمايته، بنوعيه الخيري العام والذري (أو الأهلي) الخاص.
7 - حماية أموال الأوقاف الموجودة من عقارات ومبان وأموال منقولة، والمحافظة عليها من الغصب والضياع والتعطيل، وحفظ سجلاتها.
8 - العمل على استرداد أملاك الأوقاف التي حولت إلى استعمالات أخرى بطرق غير مشروعة، ومراجعة السجلات القديمة للأوقاف في المحاكم والدوائر العقارية وغيرها لتحديد الأملاك الوقفية والبدء بإجراءات إعادتها إلى ميدانها الوقفي.
9 - إعادة النظر في إدارة أملاك الأوقاف، وبخاصة الأوقاف الاستثمارية، بما ينسجم مع إرادة الواقفين وشروطهم من جهة، ومع نصوص الشريعة ومقاصدها من جهة أخرى.
10 - وضع النظم اللازمة للتعريف بالأوقاف الخيرية العامة والأهلية الخاصة، وبيان دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتشجيع قيام أوقاف جديدة، وإعادة إدخال الأوقاف الذرية في البلدان التي ألغتها، وبخاصة بعد أن اتجهت عدة مجتمعات معاصرة متطورة إلى تأكيد أهمية هذا النوع من الأوقاف وتشجيعها.
11 - تقديم المعونات المادية والفنية والتمويلية والإدارية للأوقاف، بنوعيها الخيري والأهلي.
12 - وضع الخطط اللازمة لاستثمار الأملاك الموجودة للأوقاف وتنميتها، التي تعطلت عن العطاء خلال العصور المتأخرة لأسباب تاريخية كثيرة، وتوفير فرص التمويل المناسبة لها.
13 - تكليف وزارة الأوقاف في كل بلد بالعمل على تشجيع إنشاء أوقاف جديدة، وإقامة الهيكل المؤسسي اللازم للمساعدة في إنشاء أوقاف جديدة، وتشجيع الأفراد على إقامتها وتقديم التسهيلات الضريبية والإدارية وغيرها، وكذلك الإعانات الإدارية والمالية لها حتى تتمكن من أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي([30]).
*****
5 ـ التكافل الاجتماعي ودوره في تنمية المجتمع:
التكافل الاجتماعي:
يقصد بالتكافل الاجتماعي: أن يكون أفراد المجتمع مشاركين في المحافظة على المصالح العامة والخاصة ودفع المفاسد والأضرار المادية والمعنوية، بحيث يشعر كل فرد فيه أنه إلى جانب الحقوق التي له أن عليه واجبات للآخرين وخاصة الذين ليس باستطاعتهم أن يحققوا حاجاتهم الخاصة وذلك بإيصال المنافع إليهم ودفع الأضرار عنهم.
فهو في الأساس التزام الأفراد بعضهم نحو بعض، "وهو لا يقتصر في الإسلام على مجرد التعاطف المعنوي من شعور الحب والبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يشمل أيضًا التعاطف المادي بالتزام كل فرد قادر بعون أخيه المحتاج ويتمثل فيما يسميه رجال الفقه الإسلامي بحق القرابة وهو التزام المسلم الغني بالإنفاق على قرابته الوثيقة من الفقراء كأصوله وفروعه حيث يعتبرونه جزءًا منه ويلتزم شرعا بهم، ومن ثم فإن إنفاق الفرد على أولاده وأحفاده أو والديه أو إخوته الفقراء لا يعفيه من أداء الزكاة وذلك أن دفع زكاته إلى قرابته الوثيقة ممن يعتبرون جزءًا منه، يعتبر كأنه دفعها إلى نفسه فلا تجزيه، وهو إن أسقط عنه حق القرابة فإنه لا يسقط عنه حق الزكاة بخلاف القرابة البعيدة، فيفضل أداء الزكاة إليها متى كانوا محتاجين لقوله عليه الصلاة والسلام: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الحرم اثنتان صدقة وصلة"([31]).
وحق الماعون، والتزام الضيافة، والتزام الإنفاق في سبيل الله ، والأخذ بالتكافل الاجتماعي في الإسلام هومن قبيل تطبيق النص، وهو ما عبرت عنه الآية الكريمة بقوله تعالى: ) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (([32])، وقوله تعالى: ) وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (([33]) ، وقوله تعالى: ) وَيَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ(([34])، والعفو هنا هو كل ما زاد عن الحاجة، وقوله عليه الصلاة والسلام: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا" ، وتلخيصه عليه الصلاة والسلام علامة الإيمان بقوله: "والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"([35]).
نطاق التكافل الاجتماعي:
إن المجتمع المسلم هو الذي يطبق فيه الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة ونظاما وخلقا وسلوكا، وفقا لما جاء به الكتاب والسنة، واقتداء بالصورة التي طبق بها الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده.
وعندما يلتزم المجتمع بهذه القاعدة يجد التكامل الاجتماعي مكانه بارزا في المجتمع بحيث تتحقق فيه جميع مضامينه , ذلك أن الإسلام قد اهتم ببناء المجتمع المتكامل وحشد في سبيل ذلك جملة من النصوص والأحكام لإخراج الصورة التي وصف بها الرسول r ذلك المجتمع بقوله: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»([36])، لذا فإن التكافل الاجتماعي في الإسلام ليس مقصودا على النفع المادي وإن كان ذلك ركنًا أساسيًّا فيه بل يتجاوزه إلى جميع حاجات المجتمع أفرادا وجماعات, مادية كانت تلك الحاجة أو معنوية أو فكرية على أوسع مدى لهذه المفاهيم , فهي بذلك تتضمن جميع الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات داخل الأمة.
والتكافل الاجتماعي في الإسلام ليس معنيا به المسلمين المنتمين إلى الأمة المسلمة فقط بل يشمل كل بني الإنسان على اختلاف مللهم واعتقاداتهم داخل ذلك المجتمع كما قال الله تعالى: ) لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ(([37]) ؛ ذلك أن أساس التكافل هو كرامة الإنسان حيث قال الله تعالى: ) وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا(([38]).
التكافل داخل الأسرة:
لقد أكد الإسلام على التكافل بين أفراد الأسرة وجعله الرباط المحكم الذي يحفظ الأسرة من التفكك والانهيار.
ويبدأ التكافل في محيط الأسرة من الزوجين بتحمل المسؤولية المشتركة في القيام بواجبات الأسرة ومتطلباتها؛ كل بحسب وظيفته الفطرية التي فطره الله عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الرجل راع في بيته ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها»([39]).
ويأتي تقسيم وتوزيع المسؤوليات داخل البيت بين الرجل والمرأة بما يضمن قيام الأسس المادية والمعنوية التي تقوم عليها الأسرة فالله سبحانه وتعالى يخاطب أرباب الأسر رجالا ونساء بقوله: ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ (([40]) ، ولا تتم هذه الوقاية إلا بالتبصر بالحق وتعليم العلم النافع والإرشاد إلى أبواب الخير وهذا هو قوام التكافل العلمي والتثقيفي للأسرة، وهو مسؤولية مشتركة بين الزوجين فكلما وجد أحدهما في الآخر تقاعسا أو تقصيرا نبهه وأرشده إلى الصلاح والإصلاح. قال الله تعالى: )وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (([41]) ، وقد حث الإسلام على تنمية الود والحب الغريزي بين الرجل والمرأة في حياتهم الزوجية فقال تعالى: ) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (([42]).
التكافل داخل الجماعة: لقد أقام الإسلام تكافلا مزدوجا بين الفرد والجماعة فأوجب على كل منهما التزامات تجاه الآخر ومازج بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة بحيث يكون تحقيق المصلحة الخاصة مكملا للمصلحة العامة وتحقيق المصلحة العامة متضمنا لمصلحة الفرد فالفرد في المجتمع المسلم مسؤول تضامنيا عن حفظ النظام العام وعن التصرف الذي يمكن أن يسيء إلى المجتمع أو يعطل بعض مصالحه قال الله تعالى: ) وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (([43]) كما أن الفرد مأمور بإجادة أدائه الاجتماعي بأن يكون وجوده فعالا ومؤثرا في المجتمع الذي يعيش فيه قال الله تعالى: ) وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ(([44])، وقال رسول الله r «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا»
هذا التكافل لا يقف عند تحقيق مصالح الجيل الحاضر بل يتعدى ذلك إلى نظرة شاملة تضع في الاعتبار مصالح أجيال المستقبل, وهو ما من شأنه أن يسهم في حل كثير من الأزمات المعاصرة ويحاصر كثير من الأخطار التي تواجه مستقبل البشرية والتي نشأت من جراء لهاث هذا الجيل وراء مصالحه دون اعتبار للمستقبل البشري العام, وهي أخطار ومشكلات كثيرة لعل من أخطرها مشكلة البيئة والموارد الطبيعية، قال تعالى: ) وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا (([45]).
رعاية حق الجار: ومن مظاهر التكافل في الإسلام أيضا رعاية حقوق الجوار فقد أكد الإسلام على البر بالجار وصلته وكف الأذى عنه وإيصال الخير إليه، قال تعالى: ) وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ (([46])، وقال رسول الله r : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره»([47])، وقال: «والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: (الذي لا يأمن جاره بوائقه) »([48]), وحدد حقوق الجار فقال: «إن مرض عدته وإن أصابه خير هنأته وإن أصابته مصيبة عزيته ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها وإن اشتريت فاكهة فأهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده»([49]).
كفالة الفقراء والمساكين:
إن النصوص الإسلامية ذاخرة بالحض على كفالة الفقراء والمساكين ومشاركتهم آلامهم وتنفيس الكرب عنهم وبذل العون لهم ماديا ومعنويا.
إن الإسلام في مواجهة المشكلات الاجتماعية يفرض الحد الأدنى لاستقامة الحياة وجريانها على الصلاح ثم يفتح المجال أمام التطوع والإحسان مع الترغيب فيه والحث عليه وبيان ما ينتظر صاحبه من جزاء في الدنيا والآخرة.
كفالة الصغار والأيتام:
سبق عند الحديث عن التكافل داخل الأسرة أن الإسلام يهتم بالطفولة ويلزم الآباء برعاية الأبناء وتربيتهم حتى بلوغ سن الرشد مع القدرة على استقلالهم بالمسؤولية.
فإذا فقد هؤلاء الأبناء آباءهم فإن المسؤولية تنتقل بشكل متدرج إلى الأقارب القادرين فإذا انعدموا قامت على المجتمع بأسره.
وقد ورد في الحث على كفالة الأيتام والعناية بهم ما يبعث في نفس المؤمن دافعا قويا إلى ذلك, إضافة إلى المسؤولية الواجبة والتي تطالب الدولة , ممثلة في المجتمع , بالقيام بهذه الكفالة ) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (([50]) ، ) وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ (([51]) , ) وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ (([52])، ) أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ`فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ` وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (([53])، ) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ(([54]).
وإذا تصفحنا تاريخ الإسلام وجدنا أن كثيرا من عباقرة الإسلام والمبدعين على أكثر من صعيد كانوا قد فقدوا آباءهم وهم صغار وما ذلك إلا نتاج ملموس للتوجيهات والسياسات الإسلامية في هذا الصدد والتي أصبح المجتمع يقوم بها بشكل طوعي وتلقائي حتى في الأوقات التي تتخلى فيها الدولة عن واجبها فإن هذه العناية لم تغب إذ قام بها المجتمع وأقام لها من المؤسسات الخيرية ما يلبي حاجتها.
ومن مظاهر العناية التي أولاها الإسلام للأيتام حفظ أموالهم والسعي في تنميتها والابتعاد عن كل تصرف ضار بها ) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ (([55])، ) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (([56]), كما دعا إلى استثمارها والإنفاق عليهم)وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ(([57])، ) وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا(([58]) .
الإسلام دين الضمان والتكافل الاجتماعي:
إن الإسلام هو دين الضمان الاجتماعي من حيث التزام الدولة، وهو دين التكافل الاجتماعي من حيث التزام الأفراد، ويتمثل الضمان الاجتماعي في الإسلام في ضمان "حد الكفاية" لكل فرد يتواجد في مجتمع إسلامي أيا كانت ديانته وأيا كانت جنسيته تكفله له الدولة الإسلامية عن طريق مؤسسة الزكاة، وذلك متى عجز أن يوفره لنفسه لسبب خارج عن إرادته كمرض أو عجز أو شيخوخة ... إلخ، ثم يأتي التكافل الاجتماعي من جانب الأفراد، كعنصر مكمل لالتزام الدولة وجهودها في إزالة العوز والقضاء على القهر.
إننا نرى أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية إنما تكمن فيما يقرره الإسلام من ضرورة التعاون بين الدولة والأفراد، وأن لكل منهما مجاله بحيث يكمل كل منهما الآخر، والواقع أن الدولة لا تستطيع القيام بكل شيء، وأن تدخلها المطلق أو إحجامها المطلق، يؤدي إلى مساوئ عديدة، والمناط في الاقتصاد الإسلامي هو تحقيق التعاون والتكامل بين الدولة والأفراد على الوجه السابق بيانه([59]).
الوظائف الأساسية للمجتمع العام :
من خلال ما سبق يمكن تصوير الوظائف الأساسية للمجتمع في النقاط التالية :
(أ) ـ تأمين الشروط الأساسية للحياة المادية ؛ فمن حق كل من يعيش في مجتمع أن يلقي من الرعاية والحماية والتكافل ما يمكنه من الاستمرار في الحياة ، والإسلام أول دين شرع القتال من أجل الفقير ، وأخذ حقه من الغني ، وعلى الدولة أن تضع نصب عينيها تحقيق الكفاية من ضرورات الحياة ، ومن التعليم والتدريب والصحة وإيجاد فرص العمل لمواطنيها ، واتخاذ كل التدابير لتأمين ذلك ، وعلى كل القادرين في المجتمع أن يساعدوها في تحقيق هذه الأهداف ، وإن المجتمع الذي لا يقوم بالحد الأدنى من حاجات أفراده هو مجتمع مريض.
(ب) ـ توفير شروط الحياة المعنوية والروحية ، إذ من حق المسلم على مجتمعه أن يجد فيه الحرية والحفاظ على الحقوق ودفع الظلم وتكافؤ الفرص والنصح والتوجيه ، وتأمين كل ما يحفزه ، ويساعده على القيام بأمر الله عز وجل.
(ج) ـ تنظيم الطاقة الحيوية للفرد من خلال وسائله في ضبط أفراده ورقابته عليهم، بمعنى أن يحول المجتمع الفرد من شخص غرائزي يجري خلف شهواته ومصالحه إلى شخص مكيَّف يمارس حرياته ، ويصرف طاقاته ويؤمن مصالحه ضمن القواعد التشريعية والأخلاقية والسلوكية التي يحددها مجتمعه.
( د ) ـ إدارة التكامل ، وحل التوترات التي تحدث بين المكونات المختلفة للحياة الاجتماعية؛ حيث إن حياتنا تخضع لنظم عقائدية وتربوية وتعليمية واقتصادية متعددة ؛ ومن ثم فإن المتوقع حدوث نوع من الخلل والتصادم في علاقة هذه الأنساق بعضها ببعض مما يؤدي إلى تشويه الشخصية الاجتماعية وفقدها للتوازن ، ومن واجب المجتمع إدارة تلك التوترات ، والتخفيف منها بقدر الاستطاعة ، ولا يستطيع مجتمع أن يفعل شيئاً ذا قيمة من كل ما سبق ما لم يعتمد في تعامله أسلوب المفاتحة والنقد والمراجعة ، وقبل ذلك الشفافية والرحمة وتطبيق العدالة المطلقة([60]).
*****
6 ـ النصيحة في الدين ودورها في تنمية المجتمع:
الواجب على المسلمين فيما بينهم التناصح والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه كما قال تعالى: ) وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ(([61])، وقال سبحانه: )وَالْعَصْرِ ` إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ` إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (([62])، وقال النبي الكريم r : «الدين النصيحة " قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم »([63]).
هاتان الآيتان مع الحديث الشريف كلها تدل على وجوب التناصح والتعاون على الخير والتواصي بالحق، فإذا رأى المسلم من أخيه تكاسلا عما أوجب الله عليه، أو ارتكابا لما حرم الله عليه وجب نصحه وأمره بالمعروفونهاه عن المنكر حتى يصلح المجتمع ويظهر الخير ويختفي الشر كما قال الله سبحانه وتعالى: ) وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (([64])، وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان »([65])
إن المجتمع - كما يقول مالك بن نبي - الذي يعمل فيه كل فرد ما يحلو له ليس مجتمعاً ولكنه إما مجتمع في بداية تكونه وإما مجتمع بدأ حركة الانسحاب من التاريخ فهو بقية مجتمع.
واليهود حين أرادوا تدمير المجتمعات الغربية خططوا لتضخيم جانب الفردية على حساب الحس الجماعي حتى كثرت القضايا التي يعدها العرف هناك خصوصيات تخضع بمزاج الفرد ومصلحته، وكانت النتيجة التي انتهوا إليها تفكك تلك المجتمعات على نحو مخيف ذهب بأمن الحياة وروائها وسيعصف بكل الجهود العزيزة التي بذلت في بناء الحضارة الحديثة في يوم من الأيام.
وقد انتقلت هذه العدوى إلى بلاد المسلمين فصار كثير من المسلمين غير مستعد لقبول نصيحة من أحد بحجة أن ما يلاحظ عليه يعود إلى خصوصياته التي لا تقبل أي نوع من التدخل. وهذا الصنف من الناس - وهو يمثل اليوم في المسلمين الأكثرية - على غير دراية بفلسفة هذا الدين في إقامة المجتمعات وإنشاء الحضارات مما يجعل رؤيتهم للحياة كثوب ضم سبعين رقعة مختلفة الأشكال والألوان.
وبإمكان المسلم من خلال نظرة سريعة في بعض النصوص أن يتعرف وجهة الشريعة في هذا، وإليك حديث السفينة الذي وضع النقاط على الحروف في هذه المسألة بصورة مدهشة، فقد روى النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي r : «مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً»([66]).
إن هذه السفينة تمثل المجتمع الإسلامي الذي توحدت عقائده وتوحد اتجاه سيره وتوحدت غاياته والمخاطر والتحديات التي تواجهه، وإن القائم في حدود الله تعالى هو تلك الفئة الصالحة الملتزمة بشرع الله الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر، وإن الواقعين فيها هم أولئك الذين ينتهكون حرمات الله من ترك الواجبات والوقوع في المحرمات، والحديث يقرر أن ما يتوهمه بعض الناس من خصوصياته ليس كذلك كما أن الذين احتلوا أسفل السفينة كانوا واهمين في ظنهم أن لهم الحرية الكاملة في التصرف في أرض السفينة ، وذلك لأن تصرفهم فيها بخرقها يمس مصالح الذين فوقهم بل مصائرهم([67]).
ومن ثم وجب الأخذ على أيدي العصاة وعدم مداهنتهم وملاينتهم؛ لأن المعصية حين تشيع في الناس يستوجبون نزول العقوبة وذهاب الريح، ولا تشيع الفاحشة إلا حين يغض المجتمع الطرف عنها وطالما أجهض الجهد الإنساني الضخم في إعمار الأرض بسبب التقصير في جانب العبودية لله تبارك وتعالى وشواهد الماضي والحاضر ناطقة بذلك، وكيف لا والله تعالى يقول: ) وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابِ (([68]) ، وكيف لا والرسول r يقول مجيباً لمن سأله: أنهلك وفينا الصالحون؟ : «نعم إذا كثر الخبث»([69]).
واستحق بنو إسرائيل اللعن في كتاب الله على ألسنة أنبيائهم؛ لتركهم التناصح والأمربالمعروف، كما قال جل وعلا: ) لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ` كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ(([70])، فحق عليهم - بعدم التناصح، وراحة النفس بالجريمة التي يعملها الآخرون - أن وجب عليهم لعن الله، وهو الطرد من رحمته جل وعلا.
والعصيان والاعتداء جريمة؛ لأن في ذلك مجاوزة لحدود الله التي حد لعباده، وأعظم الجرائم عصيان الله في أمره، والاستكبار على شرعه، كما فعل إبليس- لعنه الله- حيث أخرجه ذلك من رحمة الله واستحق مقته وغضبه إلى الأبد، فأعظم بها من خسارة، قال ابن كثير في تفسيره: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي، نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم »([71]) قال يزيد، وأحسبه قال: «في أسواقهم، وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال: لا والذي نفسي بيده، حتى تأطروهم على الحق أطرا » وفي رواية ابن مسعود رضي الله عنه: «كلا والله لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم، ولتأطرنه على الحق أطرا، أو تقصرنه على الحق قصرا "([72]).
فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأسس المتينة، التي تقي المجتمعات من الجريمة، وبهيمنة الرجال العارفين لما يدعون إليه المدركين حقيقة ما ينهون عنه بحكمة وموعظة حسنة يمكن بتوفيق من الله، وبالنية المخلصة، والصدق في القول والعمل - حماية للأمة من تسلط فئة نبت الشر في قلوبهم، وفقدوا هيمنة الرقابة الذاتية لنقص إيمانهم، والرقابة الأسريةلعدم توجيههم وقت التهيؤ الذهني، والاستعداد العقلي للقبول؛ لأن أمثال هؤلاء في المنزلة الثالثة، بحيث تردعهم السلطة، وتؤثر فيهم التوجيهات، وتخوفهم الجزاءات الملائمة معهم، ذلك أن سلطة الآمرين بالمعروف، والناهين عن المنكر يجب أن تكون مستندة إلى قاعدة صلبة من الإيمان، الذي يملأ النفس بحرارة اليقين، ويمدها بالشحنات الدافعة إلى العمل، كما يجب أن تدعم بالسلطة الشرعية، لينزجر المعاندون، ويقمع المكابرون، ويجازى المتجاوزون المصرون؛ لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه.
لقد جعل الله جل وعلا في شرائع دين الإسلام، وفي كل أمر ونهي حكمة بالغة، تنصلح بها الحياة في كل زمان ومكان، فالزواجر والحدود التي شرعها الله، ونظمتها تعاليم الإسلام، ليست إلا وقاية للمجتمع من تسلط فئة على فئة، وحماية لأفراده وأمنه من أصحاب النزعات الشريرة، أو الإغراءات المادية.
ولما كان الدين النصيحة والتوجيه، فإن الفرد مسئول بأن يكون عينا تراقب الأضرار؛ للتنبيه عليها والتساند مع الجهات المعينة في إنكار المنكر، والترغيب في المعروف، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم »([73]).
فنصح العامة يتم بالتوعية والتنبيه على الأخطاء برفق ولين؛ لأن الثمرة لا تتم إلا بهما، أما إذا خيف اتساع النطاق، واستمراء الباطل، فيجب على الجهة المعنية أخذهم على الحق بالقوة([74])؛ لأن الأمن حين يضطرب حبله لا يضطرب على الطالحين وحدهم، وإن الأسعار حين تغلو لتفوق طاقة الناس لا ترتفع بالنسبة للطالحين فقط، وإن العدو حين يستبيح الحمى لا يستثنى أحداً وهكذا ...!
وإذا كان أصحاب الأهواء والشهوات لا يبصرون أكثر من مواقع أقدامهم ولا يعبأون بحاضر ولا مستقبل فإن على المجتمع أن يتحمل المسؤولية تجاه حاضره ومستقبله وآخرته.
(1) ـ د. نبيل رمزي : علم اجتماع المعرفة، ط/1 ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، ص 95.
(1) ـ د. عبد الكريم بكار : مدخل إلى التنمية المتكاملة ـ رؤية إسلامية ، ط/1 دار القلم ، دمشق ، 1999م، ص 241 ـ 246، بتصرف.
(1) ـ سورة الحج الآية 30 .
(2) ـ سورة الحج الآية 32.
(3) ـ د. محمد بن سعد الشويعر: الوقاية من الجريمة في التشريع الجنائي الإسلامي، بحث بمجلة البحوث الإسلامية الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، عدد (29) ، ص150 ـ 152.
(1) ـد. محمد عثمان الخشت : المجتمع المدني ، سلسلة الشباب العدد (8) الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 2004م، ص 11.
(2) ـ د. محمد عثمان الخشت : المجتمع المدني ، مرجع سابق ، ص 6.
(3) ـ المرجع السابق ، ص 12 ـ 13.
(1) ـ المرجع السابق ، ص 16.
(2) ـ انظر: ابن بطوطة : تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ، تحقيق : د. علي منتصر الكتاني ، ط/4 مؤسسة الرسالة ، بيروت 1405هـ ، (1/118).
(1) ـ د. محمد عثمان الخشت : المجتمع المدني ، ط/1 سلسلة الشباب ، سلسلة نصف شهرية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة ، العدد (8) ص27 ـ 30.
(1) ـ د. محمد عثمان الخشت: المجتمع المدني ، مرجع سابق ، ص77 ـ 80 بتصرف.
(1) ـ رواه البخاري(1470) ، والنسائي (2589)، ومالك في الموطأ(2/998)، وأحمد (7490)، وابن زنجويه في الأموال(2080).
(2) ـانظر في تفصيل ذلك: د. محمد شوقي الفنجري: الإسلام والتأمين ، طبعة سنة 1979م، لناشره عالم الكتب بالقاهرة والرياض، ص21 وما بعدها، وكتاب : التوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول له أيضاً ، ص 71.
(1) ـ سورة البقرة الآية 272.
(2) ـ سورة آل عمران آية: 92.
(3) ـ سورة الحج آية: 77.
(4) ـ سورة آل عمران آية: 115.
(5) ـ سورة البقرة آية: 280.
(6) ـ رواه مسلم (1631) ، وأبو داود (2880) ، والترمذي(1376) ، والنسائي(3651) .
(7) ـ رواه البخاري (2737) ، ومسلم (1633) ، والترمذي (1375) ، والنسائي (3597) ، وأبو داود (2878) ، وابن ماجه (2396) ، وأحمد (2/55) .
(8) ـ ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري ، محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة - بيروت، 1379هـ، (5/402).
(9) ـ رواه الترمذي (3703) ، والنسائي (3608) .
(1) ـ رواه البيهقي في السنن الكبرى (6/265)برقم(11896).
(1) ـ انظر : أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي : حجة الله البالغة ، تحقيق: السيد سابق ، ط/1 ، دار الجيل، بيروت - لبنان1426 هـ - 2005م ، (2 / 180) .
(2) ـ سورة المائدة الآية 2 .
(1) ـ أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية للكبيسي (1 / 138) .
(2) ـ المرجع السابق (1 / 138) .
(1) ـ د. عبد الله بن أحمد الزيد: أهمية الوقف وحكمة مشروعيته ، بحث بمجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، عدد 36 ، ص 208 ـ 211.
(1) ـ د . بدر بن ناصر البدر: الوقوف على القرآن، مقال بمجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، عدد 77، ص162.
(2) ـ رواه النسائي (2582) ، وابن ماجه (1844) ، وأحمد (16227) ، والطبراني في الكبير(6212)، وقال الألباني: صحيح.
(3) ـ سورة الحجرات آية: 10.
(4) ـ سورة البقرة آية: 195.
(1) ـ سورة البقرة آية: 219.
(2) ـ محمد شوقي الفنجري: التوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول ، وزارة الأوقاف، ص 72 ـ 74.
(3) ـ رواه مسلم (2586) ، وأحمد (18373) ، والطبراني في الكبير (21/124) ح (150).
(4) ـ سورة الممتحنة آية: 8.
(5) ـ سورة الإسراء آية:70.
(1) ـ رواه البخاري(893)، (2409)، ومسلم(1829)، وأبو داود(2928)، والترمذي(1705).
(2) ـ سورة التحريم آية:6.
(3) ـ سورة التوبة آية: 71.
(4) ـ سورة الروم آية: 21.
(5) ـ سورة التوبة آية: 71.
(6) ـ سورة المائدة آية:2.
(1) ـ سورة الحج آية: 40.
(2) ـ سورة النساء آية:36.
(3) ـ رواه البخاري(6019) ، ومسلم(47) ، ومالك في الموطأ(2/929)ح(22)، الطبراني في "الأوسط" (8841).
(4) ـ رواه مسلم (46) ، والطيالسي في مسنده(1437) ، وأحمد(16372).
(5) ـ رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق(247) ، والبيهقي في شعب الإيمان(9113)،
(6) ـ سورة الضحى آية: 9.
(1) ـ سورة النساء آية: 36.
(2) ـ سورة البقرة آية : 177.
(3) ـ سورة الماعون :1 ـ 3.
(4) ـ سورة الأنفال آية: 41.
(5) ـ سورة الأنعام آية:152، والإسراء:34.
(6) ـ سورة النساء آية: 10.
(7) ـ سورة البقرة آية : 220.
(8) ـ سورة النساء آية :5.
(1) ـ د.محمد شوقي الفنجري: الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول، وزارة الأوقاف ، ص 74 ـ 75.
(1) ـ د. عبد الكريم بكار: مدخل إلى التنمية المتكاملة ، ص245 ـ 246.
(1) ـ سورة المائدة آية:2.
(2) ـ سورة العصر الآيات :1 ـ 4.
(3) ـ رواه مسلم (55) ، والنسائي (4197)، وأبو داود (4944) ، وأحمد (4/102).
(4) ـ سورة التوبة الآية 71.
(5) ـ رواه مسلم (49) ، والترمذي (2172) ، والنسائي (5009) ، وأبو داود (1140) ، وابن ماجه (1275) .
(1) ـ رواه البخاري(2493) ، والترمذي (2173) .
(2) ـ د. عبد الكريم بكار: في إشراقة آية ) كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ( ، مقال بمجلة البيان ع. 23، ص48. تصدر عن المنتدى الإسلامي.
(3) ـ سورة الأنفال آية: 50.
(4) ـ رواه البخاري (3346) ، (7059)، ومسلم (2880) ، والترمذي (2187).
(5) ـ سورة المائدة آية: 78 ، 79.
(1) ـ رواه الترمذي (3047) ، وأبو داود (4336) ، وابن ماجه (4006) .
(2) رواه أبو داود(4336).
(3) ـ رواه مسلم (55) ، والنسائي (4197) ، وأبو داود (4944) ، مسند أحمد بن حنبل (4/102).
(4) ـ د. محمد بن سعد الشويعر: الوقاية من الجريمة في التشريع الجنائي الإسلامي، بحث بمجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، عدد (29) ، ص153 ـ 154.